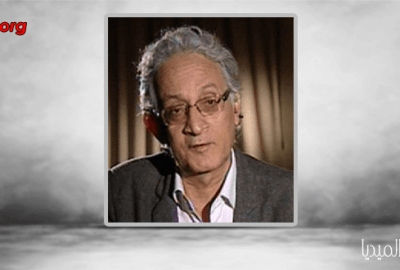عبد الله السناوي عن ترشح السيسي : كل السيناريوهات محتملة
الشيطنة والشخصنة: جذور فى الأزمة (نقًلا عن الشروق)
بأى قياس طبيعى فإن الحديث عن الانتخابات الرئاسية والتنافس فيها والبحث بين بدائل وفق برامج تطرح على الرأى العام هو من أسس الدول الحديثة.
أى تنكر للقواعد الديمقراطية عودة إلى الماضى، كأننا لم نتعلم شيئا من ثورتين ونضع مستقبل البلد كله بين قوسين كبيرين.
الكلام المرسل عن أنه لا بديل معيبا فى ذاته، معيبا تماما، فمصر ليست دولة صغيرة ولا هامشية، وتاريخها يشفع لها فى صناعة الرجال والقيادات، فضلا عن أن الإرادة العامة وحدها هى التى تقرر ما تريد عبر صناديق الاقتراع فى انتخابات نزيهة وشفافة.
من حق الرئيس «عبدالفتاح السيسى» أن يترشح لدورة ثانية، كما من حق أى مواطن آخر أن يتقدم لنيل الثقة العامة.
هذه قاعدة دستورية لا يصح المساجلة فيها.
وقد أعرب عن تطلعه لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن التوقيت أثار تساؤلات جدية عن أسبابه ومغزاه.
بذات القدر أعربت جماعة من الباحثين الشبان عن تطلع آخر لصياغة برنامج انتخابى يزكون بمتقضاه مرشح رئاسى فى الانتخابات المقبلة، وقد تعرضوا لحملات اغتيال معنوى رغم قانونية ودستورية ما يجتهدون فيه بغض النظر عن الرأى فيما قد يتوصلون إليه.
فى التوقيت تساؤلات أخرى عن الأسباب والمغزى.
حتى الآن لم تعرب شخصية عامة معروفة واحدة نيتها الترشح لمنافسة «السيسى»، ربما إدراكا أن الوقت مازال مبكرا أو خشية من حملات اغتيال معنوى.
الكلام الانتخابى المبكر تعبير عن أزمة لا تنافس بالنظر إلى حقائق الموقف فى مصر.
لا أحد بوسعه أن يتوقع مطمئنا الصورة التى سوف يكون عليها المسرحين السياسى والاجتماعى قبل منتصف (٢٠١٨)، أو مدى خطورة المتغيرات التى تطرأ خلال تلك الفترة الطويلة نسبيا.
يصعب التكهن بالمستقبل القريب فى بلد تعصف به مشكلاته من يوم لآخر من الأزمة الاقتصادية بتبعاتها إلى أزمات الإقليم بمخاطرها.
كل شىء قلق ومتحول ويقف عند منحدرات خطرة.
ما يستحق التوقف عنده بجدية ضمان سلامة البلد، القواعد الحاكمة قبل الرئاسات المتنفذة.
وتلك مسألة غائبة بقسوة.
نحن أمام أزمات وجودية الخروج منها ليس سهلا وعلى أبواب أيام صعبة لا يملك أحد أن يزيح سيناريوهاتها الخطرة بإشارة من يد.
من بين تلك السيناريوهات اضطرابات اجتماعية واسعة، لا أحد يعرف متى وأين وكيف، بأثر الأزمة الاقتصادية وغلاء الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
نقطة البدء المصارحة بالحقائق، لا نصفها، والمشاركة فى صنع السياسات بأكبر قدر من الجدية والشعور بالمسئولية العامة، وفتح المجال العام لكل اجتهاد ونقد دون خشية تشهير أو انتهاك.
إذا لم تحدث مثل تلك المشاركة فلا أمل فى تماسك وطنى، وكل شىء سوف يوضع على منحدر قبل أية انتخابات مقبلة.
أخطر ما يحدث الآن الإفراط فى شخصنة الأزمات دون نظر إلى حقيقتها، ما متوارث منها وما مستجد، ولا إلى سبل الخروج منها بأقل خسائر ممكنة.
كيف بدأت الشخصنة؟
عندما بدأت الشيطنة باغتيال الشخصية وانتهاك الحياة الخاصة وبث تسجيلات هاتفية فى خرق صريح لأى قانون.
كانت تلك الخطوة الأولى التى صاحبت حملات ممنهجة ضد ثورة «يناير» واعتبار كل من شارك فيها متآمرا بالضرورة وإطلاق يد الأمن فى الحياة العامة.
كما تقول قوانين الحركة فإن لكل فعل رد فعل مساو له فى القوة ومضاد له فى الاتجاه.
وقد جرت شخصنة مضادة على شبكات التواصل الاجتماعى وارتفع منسوب الكراهيات المتبادلة.
بإغلاق المجال العام لم تعد هناك وسيلة لصنع التوافقات أمام الأزمات المستحكمة، وبدا كل شىء مشيطنا بغير أدنى حق أو مشخصنا قبل أى فحص.
فى أزمة نقابة الصحفيين جرت تلك الشيطنة، ومن أخطر ما تردد أن «كل من ليس معنا فهو ضد الدولة».
وفق الدستور والقانون فإن هناك من لا يوافقون السياسة العامة للحكم الحالى دون أن يعنى ذلك أنهم متآمرون وطابور خامس ويسعون لهدم الدولة.
الرئيس «السيسى» بنفسه قال إن نقد نظامه فى الصحافة الغربية لا يعقل أنه كله مؤامرة.
رغم ذلك فإن حديث المؤامرة لا يتوقف على شاشات الفضائيات حتى بدت القدرة على الحوار والإقناع شبه منعدمة وكسب الاحترام العام مستحيلا.
هناك تعبيرات أكثر انضباطا تكاد أن تكون قد غابت تماما كـ«حرية الرأى والتعبير» و«الحق فى الاختلاف والمعارضة» و«الاحتكام إلى دولة القانون» لا «دولة الخوف».
وفى أزمة المستشار «هشام جنينة» رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق جرى التوسع فى الشيطنة والتشكيك فى النوايا دون بحث جدى فى أرقام الفساد الحقيقية وتعقب مؤسسته التى تعتقد أنها أقوى من أى مؤسسة أخرى فى الدولة.
فى الحالتين تبدت روح انتقام أضرت بفرص استكشاف الحقيقة والعمل على تطويق الأزمات لا تصعيدها.
هكذا مضى الأمر فى أزمات ثالثة ورابعة وعاشرة، أخطرها أزمة الدولة مع شبابها والتباطؤ الفادح فى الإفراج عن المعتقلين السلميين رغم الوعود الرئاسية المتكررة.
عندما جرت شيطنة الرأى الآخر تولدت شخصنة الأزمات.
بطبيعة الحال فإن أية رئاسة تتحمل المسئولية العامة للسياسات المتبعة، لكن القضية ليست بمثل هذه السهولة عند النظر إلى جذور الأزمات.
بافتراض أن الرئاسات تغيرت، فما الذى سوف يتغير فى طبيعتها إذا مضت السياسات فى ذات الطرق.
القضية فى السياسات قبل الرجال، والسياسات مسألة رؤية، والرؤية قبل البرنامج.
عندما غابت الرؤية التى تنتسب للرهانات الكبرى فى تأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة، وغابت أية خطط إصلاحية فى الأجهزة الأمنية، وتراجعت أية وعود فى العدالة الاجتماعية، وجرى اصطناع تناقض بين «يناير» و«يونيو» أصاب العطب جذر الشرعية وتراجعت الشعبية بصورة لم تكن متوقعة.
بين الشيطنة والشخصنة أفلتت الأعصاب إلى درجة تشبه التلف.
لا يعقل أن يقال إن كل انتقاد للسياسة الحالية تآمر على الرئيس والنظام والدولة.
ولا يعقل بالمقابل تلخيص كل الأزمات فى رجل واحد، بغض النظر عن أية مواريث صعبة تسلمها.
فكرة عدم ترشح «السيسى» لدورة رئاسة ثانية دعت إليها مجلة «الإيكونوميست» البريطانية الاقتصادية الشهيرة فى عددها المثير للجدل «تخريب مصر»، وتولدت إثرها حملات مضادة أوغلت فى الهيستيريا الإعلامية بصورة ألحقت أضرارا فادحة بصورة الحكم أمام مجتمعه قبل عالمه.
إذا كان هناك من يتحدث عن مؤامرة فإن مثل هذا النوع من الأداء الإعلامى البدائى يشجع عليها.
الذين يثقون فى شعوبهم لا يهتزون أمام أى نقد كأنه كارثة توشك أن تنقض وأمام كل رأى كأنه تعبير عن طابور خامس ينسق حركاته مع إشارات مايسترو غامض.
قضية الثقة هى ذاتها قضية الشرعية وجوهر التقدم إلى المستقبل بأمان.
عندما تغيب القواعد الديمقراطية فكل الطرق مفتوحة على المجهول وكل شرعية مرشحة للتآكل وكل السيناريوهات محتملة.