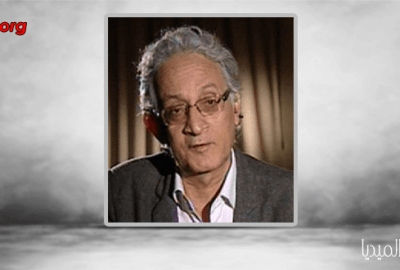عبد الله السناوي يكتب: صراعات فى الظلام
نقلًا عن جريدة الشروق
بعد ما يقارب ست سنوات على إطاحة الرئيس الأسبق «حسنى مبارك» ارتفعت على نحو غير مسبوق دعوات رد اعتباره كأحد أبطال حرب أكتوبر وبدت وجوه نظامه بديلا محتملا عند أول منعطف.
أيا كانت الاتهامات المنسوبة إليه والأحكام الصادرة بحقه فإن التاريخ هو التاريخ، لا يملك أحد تغيير وقائعه، ولا إنكار أية أدوار لعبت على مسارح أحداثه الكبرى.
من مصلحة مصر وسلامة ذاكرتها العامة قراءة التاريخ بالوثائق لا الأهواء، بالحقائق لا الدعايات.
وقد كانت تجربة «مبارك» على مدى ثلاثين سنة من حكمه بالغة السلبية فى النظر إلى أدوار القادة العسكريين الآخرين فى حرب أكتوبر.
جرى التلاعب بالتاريخ على نحو منهجى حتى يخلو المشهد لرجل واحد هو صاحب الضربة الجوية الأولى، كما فعل سلفه «أنور السادات» «بطل الحرب والسلام»، وكان ذلك افتراء على ملحمة أكتوبر والتضحيات التى بذلت والأدوار التى أديت فى ميادين القتال.
كمثال واحد، جرى حذف صورة رئيس أركان القوات المسلحة فى حرب أكتوبر الفريق أول «سعد الدين الشاذلى» من لوحة غرفة العمليات فى بانوراما أكتوبر وأودع السجن.
رغم ذلك كله فإن إنصاف أدوار «مبارك» العسكرية، بلا تهويل أو تهوين، قيمة تاريخية لا يصح التفريط فيها بأية ذريعة، أو إنكارها بدواعى الانتقام.
المشكلة الحقيقية فى طلب رد اعتبار قائد سلاح الطيران فى حرب أكتوبر أنه يتجاوز موضوعه المباشر إلى هدفه الأصيل.
ما هو مباشر فى طلب الإنصاف يتعين أن يشمل جميع القادة العسكريين الكبار وإدانة التصرفات التى ارتكبها «مبارك» فى تهميش ذكراهم أو إنكار أدوارهم ــ هكذا القواعد التاريخية والأخلاقية.
وما هو أصيل فى نفس الطلب أخطر وأبعد من إثارة التعاطف مع رجل من الماضى، بكل ما فيه وما عليه، إلى حسابات مستقبل السلطة فى مصر.
الكلام بمنطوقه وسياقه يكاد يخرج من الظلال ويعلن عن نفسه بوضوح والحقائق الأساسية تنبئ عن صراعات محتملة بين جماعات متقاربة فى التوجهات والسياسات، ترى كل منها أنها الأولى بالحكم والقدرة على أعبائه.
لماذا ذلك ممكن الآن؟
أول إجابة: تعثر المسار السياسى لما بعد ثورة «يناير»، لا جرت عدالة انتقالية، ولا حاسبنا الذين أفسدوا الحياة السياسية والاجتماعية، لا طرحت وثائق ومستندات على الرأى العام تروى قصة ثلاثين سنة من حكم مبارك وكيف انتهت بالثورة عليه؟
وثانى إجابة: أن الثورة نفسها اختطفت مرتين، الأولى من جماعة الإخوان المسلمين فى يناير.. والثانية من الماضى فى يونيو.
معضلة الماضى أنه لم يمسك مباشرة بمقاليد السلطة، وتصور أن الذين صعدوا إليها سوف يتولون رد اعتبار «مبارك» وإعلان أن «يناير» مؤامرة.
كملوك «البربون» فإنهم «لا ينسون ولا يغفرون ولا يتعلمون»، هكذا عاد اسم رجل لجنة السياسات القوى «أحمد عز» للتداول، رغم أنه قد وصلته رسائل عديدة بعدم العودة للعمل السياسى.
بتراجع نسب الهيبة على نحو فادح فإن أحدا لم يعد يعر اهتماما بأية رسائل.
القضية ليست أن يكتب رأيا فى شأن عام، إنما فى تطلعه للعودة إلى المجال السياسى لاعبا رئيسيا يجمع ما تبعثر من أنصار ليعود بهم إلى الحكم عبر المرشح المحتمل الفريق «أحمد شفيق»، أو أى وجه آخر تتوافر فيه المواصفات نفسها.
الظروف كلها تختلف الآن عما كانت فى «يناير»، التى تعرض خلالها أركان نظام «مبارك» إلى ملاحقات ومحاكمات قيدت حركتهم فى السجون أو خارجها، بدواعى الخوف من مصائر مشابهة.
هكذا تخلف أنصار النظام عن المشاركة فى أول انتخابات نيابية وبدا الخروج من المسرح كاملا وخشية العزل السياسى ماثلة.
عندما افتقدت ما بعد «يونيو» أية رؤية للمستقبل، واضحة ومقنعة، جرت استعارة الماضى فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية وجرى إخلاء المسرح من أربع قوى على التوالى.
الأولى، جماعة الإخوان المسلمين، بثورة الغضب على حكمها، وقد أفضى لجوؤها إلى العنف إلى عزلة شعبية حقيقية تومئ بالغروب.
الثانية، جماعات الشباب المسيس، التى دخلت فى صدام مبكر وافتقدت أية أدوات باستثناء التظاهر للتعبير عن نفسها واكتساب ثقة الجمهور، الذى كان يضع الاستقرار والأمن على رأس أولوياته وقد جرى استخدام حماسه، للتنكيل به وتصفية الحسابات معه والتشهير بالثورة كلها.
والثالثة، الأحزاب والقوى السياسية التى كانت آخر تجليات قوتها «جبهة الإنقاذ الوطنى»، فقد همش كل ما هو سياسى بغض النظر عن توجهاته وتحالفاته، وصمم قانون الانتخابات النيابية ليخرج البرلمان على النحو الذى هو عليه ضعيفا وملحقا بالسلطة التنفيذية.
والرابعة، النخب السياسية والثقافية والإعلامية والأكاديمية، وكل ما له قيمة ولديه فكر وتصور، وترافق تهميشها مع تجفيف المجال العام وحملات اغتيال الشخصية والتشكيك فى كل رأى يجتهد خارج السياق الرسمى.
أدى ذلك كله إلى فقر فى الأفكار والتصورات والرؤى، وبدا كل شىء هشا والتوافق الوطنى مستبعدا واحتمالات عودة الماضى ممكنة بالوجوه المباشرة.
اللافت أن تغول الأمن وإطلاق يده فى الحياة العامة سحب من رصيد النظام ودخل فى حساب الماضى الذى يتأهب لاستعادة ما خسره.
بتنحية السياسة جرى إفساح المجال لمراكز قوى جديدة من بعض رجال الأعمال وبعض الأمن وبعض الإعلام أخذت تعمل على تصفية الحسابات مع «يناير» زاعمة أنها من أطاحت بحكم الجماعة، كما لو أن «يونيو» لم تكن ثورة شعبية بل ثورة مضادة تعمل على استعادة الماضى بكامل مقوماته ووجوهه.
وذلك مشروع اضطرابات لا سبيل لوقفها، أكبر وأخطر مما قد تتعرض له مصر الآن.
بالحساب التاريخى العودة مستحيلة، قد تحدث مؤقتا لكن الخسارة مؤكدة فى النهاية، كما حدث فى أعقاب الثورة الفرنسية.
مما يشجع الماضى على المضى قدما التراجع الفادح فى شعبية الحاضر تحت ضغط الأزمات الاجتماعية المتفاقمة وارتفاع معدلات سوء الأداء العام.
هناك الآن سؤال يلح: ألم تكن أيام «مبارك» أفضل مما نحن فيه الآن؟
خطورة السؤال فى تمدده بين قطاعات سياسية واجتماعية متناقضة تماما، لا يجمعها وثاق ولا ثقة.
بالحساب السياسى فإن عودة الماضى بالوجوه والسياسات معا، احتمال غير مستبعد، فهم الأكثر جاهزية بالمال والإعلام والدعم الإقليمى والمسرح خال تقريبا.
المفارقة الكبرى فى الصراعات المكتومة الجارية أن كتلها الرئيسية متداخلة ومتنافرة فى الوقت نفسه.
هناك مؤشرات متواترة على مثل تلك الصراعات المكتومة، ومعضلتها أن كتلها الرئيسية متداخلة من حيث جوهر السياسات العامة ومتنافرة من حيث جدارة تمثيلها.
كلما تعثر الحاضر فى أزماته المستعصية يستشعر الماضى قوته كبديل مرجح.
بصورة ما فإن كليهما لا يرتاح للآخر، ولا يثق فيه، رغم اتفاق التوجهات فى أغلبها.
احتمالات الصدام فى الظلام ماثلة، وهذه من قواعد السلطة، أية سلطة، غير أن المستقبل قضية أخرى.