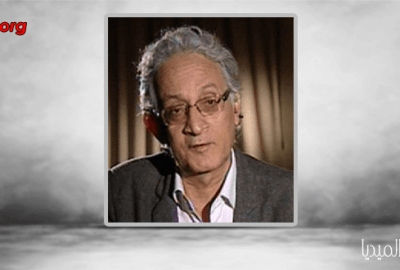عبد الله السناوي يكتب : القرار المستقل وما حوله
نقلاً عن “الشروق”
تلخص قضية استقلال القرار الوطنى، بمعاركها الكبرى وانتكاساتها المروعة، التاريخ المصرى الحديث كله.
بتلخيص آخر فإنها المرجع الرئيسى للحكم على النظم السياسية، التى مرت على مصر منذ تأسيس دولتها الحديثة على عهد «محمد على»، فلا هى عابرة ولا مؤقتة ولا تتوقف عند أزمة ولا تصنعها دعاية.
وقد كان التصويت المصرى فى مجلس الأمن الدولى على مشروع القرار الروسى بشأن الأزمة السورية داعيا لاستعادة مفردات «استقلال القرار الوطنى» فى التداول العام.
رغم جرأة التصرف على نحو مستقل فى أزمة معقدة وحساسة فإنها لا تؤشر بذاتها على تحول جوهرى فى إدارة الملفات الإقليمية ولا نزوع مؤكدا للخروج من شبه العزلة إلى حيوية المبادرة.
بأى حساب سياسى فإننا نتحدث عن أزمة محدودة فى ظروفها وسياقها مع السعودية لا عن مراجعة حقيقية لطبيعة العلاقات معها، إذا ما كانت استراتيجية على قواعد الندية والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة أم أنها بالافتراض تبعية استدعت غضبا جامحا من طرف عندما تصرف الآخر وفق ما يعتقده فى مجلس الأمن.
أرجو أن نلتفت ــ أولا ــ إلى أن مشروع القرار الروسى، الذى يدعو إلى الفصل بين المعارضة المسلحة والجماعات التكفيرية فى حلب يناقض مشروع القرار الفرنسى، الذى يدعو إلى منطقة حظر جوى فوقها بما يضفى حماية أممية على تلك الجماعات.
لا يوجد أحد فى العالم مستعد أن يصدق أن القرارين ليسا متناقضين، فإذا ما خرج المتهمون بالتطرف والإرهاب من شرق حلب فإن المعارضة المسلحة تفقد أى وزن لها أمام الجيش السورى وحلفائه، وهذه ضربة قاصمة للحسابات السعودية والتركية والقطرية والغربية والأمريكية، وإذا ما بقوا تحت مظلة حظر الطيران فإن ذلك يسحب على المفتوح من الرصيدين الروسى والإيرانى.
اللافت أن مصر مستبعدة اليوم (السبت) فى لوزان، حيث يعقد اجتماع لوزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا بالإضافة إلى السعودية وإيران وتركيا وقطر لبحث إمكانية حلحلة الأزمة السورية بعد موقعة مجلس الأمن وفشله فى إصدار أى قرار.
لا معنى إذن للحساسيات السعودية من صورة ضمت وزيرى خارجية مصر وإيران فى محفل دولى مماثل إلا إذا كانت تحرم على مصر ما تبيحه لنفسها.
فى أوقات سابقة ألحت موسكو على ضم مصر إلى مشاورات «فيينا» بشأن الأزمة السورية، ولم تكن الولايات المتحدة ولا حلفاء آخرين فى الإقليم متحمسين لذلك الطلب.
لماذا لم تلح موسكو هذه المرة؟
الإجابة أنها لا تعرف بالضبط ماذا تريده الدبلوماسية المصرية ولا أين تقف؟
وأرجو أن نلتفت ــ ثانيا ــ إلى أن السعودية دولة إقليمية مهمة لكنها ليست قوة عظمى كالولايات المتحدة فيما بعد الحرب العالمية الثانية ولا بريطانيا عندما كانت تحتل مصر لاثنتين وسبعين سنة متصلة حتى يقال إن الاختلاف مع خياراتها هو عنوان استقلال القرار الوطنى.
إذا كان الأمر قد وصل إلى هذا الحد فإنه لابد من الاعتراف بأن أحوالنا قد تدهورت إلى ما يفوق «كوابيس كافكا».
نحن نتحدث عن مصر أكبر دولة عربية التى تولت قيادة العالم العربى لعقود طويلة بلا منازع.
بتعبير الأمير «تركى الفيصل» أحد أركان الأسرة السعودية، قبل زيارة الملك «سلمان» الأخيرة للقاهرة بأيام: «مصر القيادة الطبيعية للعالم العربى، غير أنه بسبب ظروفها الحالية تقدمت السعودية لتشاركها مسئولية القيادة».
وهو كلام دبلوماسى منضبط على حقائق التاريخ سجله فى حضور أمين عام الجامعة العربية الأسبق «عمرو موسى» والسفير السعودى «أحمد القطان» ونخبة من الشخصيات العامة المصرية على مائدة عشاء فى منزل وزير الخارجية السابق «نبيل فهمى»، الحوار تطرق إلى الأزمات المكتومة بين البلدين وضرورة المصارحة بالحقائق.
فى توقيت مقارب صرح وزير الخارجية الحالى «سامح شكرى» بأن مصر لا تسعى لقيادة العالم العربى ولا تبحث عن ريادة.
التصريح لم يكن موفقا أبدا، صحيح أن مصر فى ظروفها الحالية ليس بمقدورها أن تمسك بمقاليد القيادة، غير أن غيرها لا يقدر على أن يحل مكانها، وقد فشلت بعد معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية كل محاولات وراثة الدور المصرى من دول عربية عديدة.
أول مواضع النظر فى أى حديث عن استقلال القرار الوطنى، ما تعريفه بالضبط؟، حتى لا يفلت الكلام ويفقد أثره، وهذه مسألة رؤية فى الأمن القومى وحقائق القوة وفلسفة الحركة الدبلوماسية التى ترتب الأولويات وفق المصالح الاستراتيجية التى يسعى إليها.
وقد كشف الرئيس فى حديثه الأخير عن مجموعة عمل تناقش بعمق التجارب المصرية السابقة، لماذا لم تستكمل، وكيف نتجنب أخطاء الماضى، وقد أشار إلى تجربتى «محمد على» و«١٩٥٢»، دون أن يذكر «جمال عبدالناصر» بالاسم، ربما مراعاة لبعض الحساسيات السعودية التى تجنب ذكرها بالاسم فى معرض حديثه عن الأزمة الأخيرة.
أهم الأسئلة هنا: ما النتاج الفكرى الذى توصلت إليه مجموعة العمل الرئاسية؟.. لماذا لا يطرح للنقاش العام؟.. ثم أين المشروع الذى يتبناه الحاضر حتى يستفيد من أخطاء الماضى؟
المشروع مسألة رؤية، وهذه غائبة بفداحة وأحد أسباب تفاقم الأزمات على جميع الأصعدة.
وثانى مواضع النظر، مدى مقومات استقلال القرار الوطنى، فأى استقلال للإرادة يتطلب استقلالا اقتصاديا، وقدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لمواطنيه وأن يتسع أفق الأمل أمامهم فى غد أفضل بالحقائق التى يرونها لا بالدعايات التى لا يصدقها أحد.
يكفى أن نطل على الدلالات السياسية والاجتماعية لفيديو «سائق التوك توك»، لنعرف حجم الأنين العام من تدهور الأوضاع الاجتماعية ومعدلات عدم الرضا عن السياسات المتبعة.
فى ساعات تجاوز عدد مشاهديه على شبكة الإنترنت (١٨) مليونا، وهو رقم غير مسبوق ورسائله كاشفة.
الرئيس يقول إن التقارير تصله عن سخط الناس فى الشارع ويطالب بالتحمل لكنه لا يقدم خطة عمل تشمل عدالة توزيع الأعباء بدلا من أن تدفع الفئات الأكثر عوزا والطبقة المتوسطة الفواتير كلها.
لا يمكن لبلد تغيب عنه ثقته فى مستقبله أن يتطلع للعب أدوار مؤثرة فى إقليمه وعالمه.
للعب الأدوار الإقليمية تكاليفها، ولاستقلال القرار الوطنى معاركه، فما هى هذه المعارك التى دعت الرئيس للقول: «عايزين تبقى عندكم استقلالية بجد ماتاكلوش وماتناموش».
أخشى أن تكون دعوة مبطنة لاحتمال ارتفاعات الأسعار وغياب عدالة توزيع الأعباء وعدم مراجعة السياسات والأولويات التى راكمت الأزمة حتى كادت أن تنفجر.
أين المعركة؟
لا توجد أية إجابة تبرر أية تضحية من هذا النوع.
وثالث مواضع النظر، مدى ما تلهمه أى تجربة حكم فى الاتساق مع حقائق عصرها.
فى عصر المعلومات والاتصالات والسماوات المفتوحة لا يمكن تأميم الإعلام، أو إغلاق أبواب النقاش العام أو التهوين من ضرورات الحريات العامة وحقوق الإنسان.
إن أى تطلع للعب أدوار إقليمية ملهمة يستدعى نموذجا فى الداخل تفتقده مصر كما السعودية تماما.
الأولى، على خلفية سجل الحريات العامة وحقوق الإنسان المتراجع بفداحة.. والثانية، على خلفية ضيق نظامها عن الاتساع لمشاركة سياسية تستحقها نخبه الحديثة، التى حظت بتعليم متقدم فى أفضل الجامعات الأمريكية والأوروبية، فضلا عن سجل غاراتها فى اليمن التى أفضت إلى كوارث إنسانية لا سبيل لإنكارها وتورطها فى الدفاع عن منظمات متطرفة مثل جبهة «النصرة».
إذا ما أردنا استقلالا حقيقيا فلابد من توفير أسبابه ومقوماته لا الاستغراق فى كلام مرسل لا يقف على أية أرض صلبة.
عبد الله السناوي