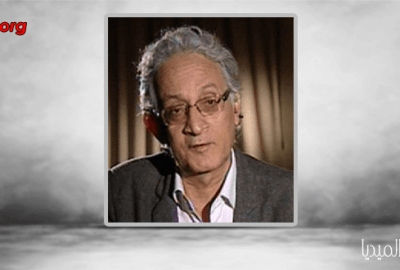عبدالله السناوي يكتب : حزب السلطة من جديد
نقلا عن جريدة الشروق
هناك نزوع معلن لإنشاء حزب سياسى جديد من موقع السلطة والإشارات تتواتر.
بحكم الدستور يمتنع على الرئيس الانضمام إلى أى حزب.
فإذا ما كان منتسبا لحزب قبل انتخابه يتوجب عليه الاستقالة أو تجميد عضويته.
هذه قاعدة دستورية لا يصح تجاهلها أو الالتفاف حولها، وإلا فإنه طعن مباشر بالشرعية وجذورها وعودة كاملة إلى الماضى وأساليبه.
لمرتين متتاليتين ثار المصريون على حزبى سلطة، الأول ــ «الحزب الوطنى» بتكوينه الأمنى البيروقراطى.. والثانى ــ «حزب الحرية والعدالة» الذراع السياسية لجماعة الإخوان.
فى المرة الأولى ــ تبدى العجز السياسى والتنظيمى مروعا أمام أول اختبار حقيقى فى الشارع أثناء تظاهرات ثورة «يناير»، تبخرت عضويته التى كادت تناهز الثلاثة ملايين، كأنها وهم من الأوهام، لم يكن على أى نحو حزبا حقيقيا أو شريكا بأى قدر فى صناعة القرار السياسى، ولا كان هناك ما يسوغ الانتساب إليه سوى السلطة وجوائزها.
وفى المرة الثانية ــ تبدت وصاية على القرار السياسى دون سند من شرعية، فالقرارات تصدر من «المقطم» حيث مكتب الإرشاد لا من «الاتحادية» حيث مقر الرئاسة، لم يكن حزب السلطة الجديد سوى ديكور من نوع آخر لتنظيم سرى يسعى لـ«التكويش» على السلطة ونفى أية قواعد ديمقراطية صعد بمقتضاها، وبمجرد خروج الجماعة من السلطة بعد تظاهرات ثورة (٣٠) يونيو تبخر حزبها، كأنه لم يوجد ذات يوم ولا عاد أحد يذكره.
بحكم تجارب التاريخ أخفقت كل الأحزاب المماثلة بدرجات مختلفة، فلم ينجح «الاتحاد الاشتراكى» فى الحفاظ على إرث ثورة (٢٣) يوليو، وبقرار من رئيس الجمهورية «أنور السادات» جرى حله دون مقاومة تذكر، ولم ينجح حزب «مصر» فى توفير ما كان يطلبه من ظهير سياسى قادر على مواجهة معارضيه الناصريين واليساريين، أعلن تأسيس «الحزب الوطنى» تحت رئاسته متجاهلا حزبه السابق، كأنه أثاث قديم فى بيت مهجور، فهرولت كل عضويته إلى حيث يقف رأس السلطة، وفى عصر خلفه «حسنى مبارك» استقرت اللعبة على قواعد الديمقراطية المقيدة وتجفيف الحياة الحزبية، حتى جاءت «يناير» من خارج السياق كله.
وقد كانت خطيئة الجماعة تنكرها للوسائل الديمقراطية التى صعدت بها، حزبها افتقد أية قدرة على الحركة المستقلة ورجلها فى «الاتحادية» أخفق أن يكون رئيسا لكل المصريين.
رغم اختلاف طبيعة الحزبين فإن النتائج واحدة بالنظر إلى حجم الغضب الشعبى الذى أطاحهما على التوالى.
ما هو مصطنع غير قابل للحياة طال الزمن أو قصر.
لا يعقل العودة إلى التفكير القديم فى بلد قام بثورتين حتى لا يرى أمامه حزب سلطة لا يعرف له برنامج أو رؤية أو دور فى صناعة القرار باستثناء دعم الرئاسات أيا كانت توجهاتها وما تتبناه من سياسات.
هناك فارق بين ظهير سياسى يشارك وظهير آخر يبايع.
المشاركة مسألة أفكار ورؤى وبرامج، وتلك مشكلة الحاضر التى أدت إلى تآكل شعبيته، والمبايعة مسألة أخرى.
بنص الدستور فإن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية وتداول السلطة.
إذا لم تكن القواعد الدستورية سارية فكل شىء معطل ومنكشف أمام كل الاحتمالات.
بالتعريف المعارضة جزء جوهرى من النظام السياسى، لكنها شوهت فى خطاب التعبئة الإعلامية، فكل صاحب رأى متهم فى نياته كمتآمر محتمل.
إن تجريف الحياة السياسية والتضييق على المجال العام حرم مصر من فرص التوافق الوطنى والتماسك الضرورى أمام أزمات عاصفة تهدد سلامة مجتمعها.
أرجو أن نتذكر أن الرئيس أعلن عشرات المرات الرفض القاطع لإنشاء حزب سلطة جديد.
من دواعيه عدم الثقة بالسياسة والسياسيين وكل ما له صلة بالحياة الحزبية، وقد كانت أغلب الأداء الحزبى أمامه مخجلا بأى قياس سياسى أو أخلاقى.
ومن دواعيه رهانه على دعم لا محدود من ظهيرين آخرين ــ المؤسسة العسكرية التى خرج من صفوفها، والقطاعات الشعبية التى أعطته تأييدا جارفا قبل صعوده للسلطة.
على أهمية الظهير العسكرى فإنه ليس بديلا عن الظهير السياسى، وذلك من حقائق الأمور.
بالتوازى فالظهير الأمنى من حقائق السلطة، أية سلطة، للإمساك بمقاليد الأمور، لكن الفارق بين حكم وآخر هو منسوب الدور الأمنى.
عندما يطلق يد الأمن فى غير أدواره فإن أشباح دولة الخوف تستخف بالوسائل السياسية، تضيق على المجال العام وتنكل بكل رأى مخالف.
للأمن ضروراته فى حفظ سلامة المواطنين والحرب على الإرهاب لكن تغوله فى الحياة العامة قضية أخرى يصعب معها أى حديث عن أية حياة حزبية تقف على أرض وتحظى باحترام.
وعلى أهمية الظهير الشعبى فإنه متغير ومتحرك، ولا يعطى صكا مفتوحا لأحد، وهذا ما حدث فى السنتين الماضيتين.
لا يصح الخلط، فى أى اقتراب جاد من مسألة الظهير السياسى بين ضروراته ومحظوراته.
لا تستغنى أية سلطة عن ظهير سياسى غير أن الفارق بين تجربة وأخرى فى طبيعة هذا الظهير.
النزوع إلى حزب سلطة جديد ينطوى على اعترافات شبه معلنة.
الاعتراف الأول، إن الظهير الشعبى قد انحسر تحت وطأة الأزمة الاجتماعية وارتباك الأداء العام وغياب أى خطاب سياسى مقنع وتردى إعلام التعبئة فى صراخ لا يقنع.
وتلك أزمة عميقة لا يقدر عليها ظهير سياسى ينشأ بالمواصفات والسياسات القديمة والوجوه التى استهلكت كل النظم.
والاعتراف الثانى، إن السياسات المتبعة وصلت إلى طريق مسدود ينذر ويهدد باضطرابات فى الداخل وضغوط من الخارج لاختصار الرئاسة بأقرب وقت.
وتلك أزمة تستدعى المصارحة بالحقائق والسعى وفق رؤى معلنة لتصحيح ما اختل، وأوله رد اعتبار السياسة والإفراج عن الشباب المعتقل بغير عنف أو دعوة للإرهاب وتحسين البيئة العامة، وثانيه رد اعتبار العدل الاجتماعى وتأكيد عدالة توزيع الأعباء بإجراءات ملموسة ترفع الظلم وتفرض ضرائب تصاعدية وتضرب مؤسسة الفساد عند جذورها.
وتلك إجراءات لا تتطلب ظهيرا سياسيا ملفقا بل وضوح الإجابات عن أسئلة لا مفر منها: لماذا انكسرت بقسوة رهانات (٣٠) يونيو فى التحول إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة؟، وأين كانت الأخطاء الفادحة التى فككت قوتها الضاربة فى جبهة الإنقاذ وجماعات الشباب والمثقفين وداخل الطبقة الوسطى المدنية؟، وما أسباب انحسار شعبية الحاضر بصورة لم تكن متوقعة قبل سنتين؟، وهل هناك فرصة للتصويب والتصحيح أم أن الوقت قد فات وما تهدم يصعب استعادته؟
أسوأ إجابة عن تلك الأسئلة القفز فوق الحقائق بالأوهام والسعى لبناء حزب سلطة جديد باسم (٣٠) يونيو.
والاعتراف الثالث، إن قانون الانتخابات النيابية، بعد تنحية السياسة، أفضى إلى برلمان أداؤه غير مقنع، ولا يقدر أن يوفر غطاء لنفسه فضلا عن السلطة.
قبل الانتخابات النيابية توافقت الأحزاب جميعها على قانون يؤكد التعددية السياسية، وأبدت قيادات أحزاب «جبهة الإنقاذ» استعدادها للمضى فى مشروع جبهة جديدة باسم «البناء الوطنى» تضم بالأساس أحزاب «الوفد» و«المصريين الاحرار» و«التيار الشعبى»، غير أن كل شىء تقوض سريعا بالضغوط المعتادة، فقد كان هناك من يرفض أى حضور فى المشهد لأية قوة سياسية مؤثرة.
إن الضعف البادى فى حزب السلطة البرلمانى ائتلاف «دعم مصر» من نتائج النظرة الضيقة لحركة المجتمع والتفاعلات فيه.
تحتاج مصر لتوافقات وطنية لا تلفيقات سياسية، فلا يمكن تجاوز الأزمات الصعبة بأحزاب سلطة جديدة، تولد باليقين ميتة.