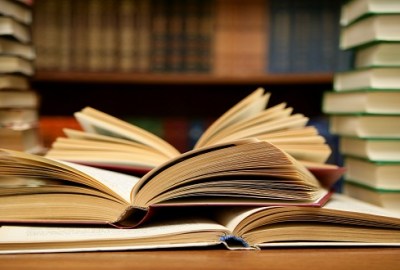أدب الظل في مواجهة الأدب الرفيع
ثمة ظواهر أدبية آخذة في الانتشار والتحقّق علي الرغم من عدم اهتمام المؤسّسة النقدية الرسميّة بها أو حتي مجرد الالتفات إليها، ودراسة أسباب ظهورها وانتشارها، وهو ما يدعو للعجب والتساؤلات في آن معًا! ومن هذه الظواهر اللافتة، ما يمكن أن يُطلق عليها »أدب الظل»، وهو ما يُقابل »الأدب الرَّسمي» الذي يَلقي الحفاوة والتقديم والتقييم من قبل النقاد والمؤسّسات الأكاديمية كالجامعات ومعاهد النقد وما ينبثق عنهما من دراسات منهجية تمتثل للنظرية، في حين يتمّ التعامل بالعداء والإهمال مع أدب الظل، حيث يُعدّه الأكاديميون أدبًا خارج التصنيف، أي لا قيمة له، فلم يتوقف عنده الدارسون بالدرس والتحليل – باستثنتاء محاولات فردية – أو حتي إبراز علاقته بمعايير الأدبيّة التي يتمّ بها تصنيف النصوص إلي جيّدة ورديئة، وأيضًا معرفة لماذا هذه الشّعبية الجارفة لهذه الكتابات علي الرغم من أنها تلقي العداء في صورة الرفض والاستهجان من المؤسّسة الرسميّة، وبمعني أدق تَلقي القمع بحكم عدم الشّرعية الثقافيّة؟! هل هذه الجماهيرية مرتبطة بما وصفته حنّة أرندت أن الناس »لا ترغب في الثقافة» بل في »ملء أوقات الفراغ» عبر مواد للتسلية والإلهاء، وبما أن الثقافة صارت سلعة، فصارت بديلاً للإلهاء. وهنا تصبح وظيفة الثقافة ليس أكثر من تلبية لحاجة مؤقتة وعابرة. وإن كان نُقَّاد المؤسّسة الرسميّة يُيرِّرون هذا الإهمال، بافتقار هذا الأدب – علي المطلق – للأدبيّة وفقًا لأحكام ومقاييس النظرية النقدية.
ومع أن مفهوم النقد حين يُعاد إلي أصوله الإغريقية يشير إلي »الفصل والحكم علي الشيء» (دليل الناقد الأدبي، سعد البازغي وميجان الرويلي ص، 301)، وقد استخدمت المفردة في إقامة العدالة، وفقًا لوظيفته في معناها البسيط التي هي »تفسير وتقييم وتوجيه للأدب» إلّا أنّ النقد تخلّي عن هذه الوظيفة، واكتفي بالرّفض والمقاطعة لما يجب أن يقيّمَهُ ويوجّهَهُ، وفق الالتزام بغاية البحث عن الحقيقة (عند بايل) التي تعني الالتزام بمنهجية النقد والتصويب المنظم للأخطاء. وهو الأمر الذي يجب أن يؤخذ علي محمل الجدّ، لمعرفة ما هي المعايير الأدبية التي تفتقدها النصوص المندرجة تحت هذا الأدب؟ أم أن النقد ما زال يحتكم لتلك المفاهيم المثالية التي كانت تُطبّق في القرن 17و18، وهو يوجِّه قرّاءه بقراءة أعمال المؤلفين الّذين تعتبر »أعمالهم بمثابة مثال» أي كلاسيكية وفقًا لتعريف قاموس روبير الكبير لكلمة كلاسيكي، وإن كان هذا يعتبر في حدّ ذاته قطيعة مع حرية القارئ مثلما كان مونتين يتصوّر.
البحث عن الأدبية
في مقابل هذه الكلاسيكية التي هي سمة روائع الأعمال، ثمة أدبيّة ما تستقطب الجمهور الجديد لهذا الأدب! وهذه الأدبية حمّالة أوجه، فهي عند النقاد تحمل جمالية معينة يبحث عنها داخل النّصوص، في حين لها عند ذائقة القرّاء سمات وخصائص أيضًا جمالية وإن كانت مخالفة عن جمالية النخبة التي بحث عنها في النص. فإخضاع النصوص لهذه الأدبيّة غير المعيارية ظالم لكثير من النصوص، فالأدبية المقصودة – هنا – وليست بمفهوم البنيويين المتمثّل في عزل النص (أي استقلاليته) عن مقارباته الخارجية، هي »مفهوم ثقافي» في المقام الأول، ومن ثمّ تتغيّر تصورات الناس لها بتغير سياقهم الثقافي بتغيّر وجودهم في التاريخ وتغير وجودهم في الجغرافيا، فضلاً عن تغير وجودهم الاجتماعي كما يقول سيد ضيف الله. فالنظرية الأدبية وفقًا لـ »أرثر إيزابرجر» تري أن »كلما كان النص أَدْني ذوقًا، كلما زاد عدد الأفراد المتذوقين والمحبين له. ومن ثم جعلت النظرية الغموض وتعدد التأويلات قرين نصوص النخبة في مقابل الوضوح قرين الأغلبية والجماهير.
ومع تجاوز الأدني ذوقًا لأن الأدني عند النخبة يقابله الأفضل عند القارئ العادي. نقف مع معضلة أخري تتمثل في غياب »العدالة الأدبية» بين هذه النصوص الدنيوية بتعبير إدوارد سعيد ونصوص النخبة. وقد سعي النقد الثقافي وفقًا لرهاناته وطموحاته، لكسر هذه النخبوية التي يتعامل بها النقد الأدبي، والانحياز إلي أعمال معينة وفقًا لهذه البرجوازية، لكن هو الآخر لم يقم بتجسير الفجوة النقدية في تتبُّع هذه الظاهرة، أو حتي تقييمها، وإنما سار أصحابه علي درب النقاد النخبويين، في غضّ الطرف عن هذه التحولات علي مستوي الكتابة وكسر مفهوم الأدبيّة الصّارم الذي وضعه النقاد المتأثرون بالمنهج البلاغي القديم كمعيار للحكم علي الأدب، وهو ما يتصل باللفظة من جهة كونها مُتخيَّرة شريفة أو سوقية مبتذلة، ومن ناحية ثانية في دراسة دوافع تشكّل ذائقة جديدة علي مستوي القرّاء، وهو ما أسهم في حالة من الرواج التجاري لسوق الكتب؛ فظهرت لنا قائمة طويلة من كتابات الخيال العلمي، وروايات رومانسية ذات طابع دينيّ، وغيرها من كتابات تنتمي إلي جنس الرواية إلا أنّها تقع تحت دائرة أدب الظل أو الأدب التجاريّ وفقًا للنقد النخبويّ.
واحدة من المشكلات الفنية التي ممكن أن توجّه إلي أدب الظلّ هي أنَّ »الفن نفسه لا يقبل التوجيه، فالتوجيه يفسده، ويحوِّله إلي دعاية تعليمية أو أخلاقية عالية الصوت» كما يقول خيري دومة، والمعني الذي أقصده ألّا يُعطي النقد مسحة شرعية لهذه الكتابات، وإنما أن يقيّمها وهذه صفة من صفات النقد الحقيقي، لا أن يدير لها ظهره.وحالة العداء التي ما زالت تتعامل بها المؤسسة النقدية مع هذه الكتابات الجديدة، تعود بنا إلي بدايات عصر النهضة العربية، حيث »عوملت الروايات المعيبة وغير الناضجة التي كانت علامة للتابعية العربية غير القابلة للتغيير » (سماح سليم: وسائل تسلية الشعب: الترجمة والرواية الشعبية والنهضة في مصر» (ص 53))؛ بعدائية شديدة، إلي حد وصفها من قبل الدكتور عبد المحسن طه بدر بأنها كتابات للتسليّة.
دوافع الكتابة
أخذت هذه الظاهرة مَنحيً خطيرًا بفضل ميل الشباب إلي مثل هذه الكتابات، وإعلائها علي الكتابات الواقعة تحت دائرة الأدب الرسمي، فظهرت أسماء تنافس وبجدارة كُتَّاب الأدب الرسمي، وكان لها الأهمية البالغة في نشأة ظاهرة البيست سيلر، كما أنها اجتذبت جمهورًا عريضًا من الأدب الرّسمي، والذي راحَ يقرأُ بشغف هذه النتاجات، ويتابع كتابه ويحثهم علي إصدار المزيد من هذه الأعمال، علي نحو ما رأينا في ظاهرة أحمد مراد، وحسن الجندي، ودينا عماد ودعاء عبد الرحمن ومني سلامة وحنان لاشين. فقد تشكّل جيل جديد من الكُتَّاب علي اختلافهم وتنوّع كتاباتهم، يتميزون بالمقروئية دون أن ينشغلوا بمسألة تصنيفهم بأنهم خارج الأدب الرسمي، فهم يُدركون جيّدًا أنهم لا ينتجون كتابات تعمد إلي إعادة إنتاج جماليات حداثية، علي مستوي اللغة أو التقنيات، أو حتي الوعي الحاد بقواعد الكتابة، بقدر ما يُقدِّمون ما يجعل القارئ مشدودًا لأعمالهم سواء علي مستوي الحبكة أو الحكاية، دون الغضّ من تحرّر كتاباتهم من أشكال الكتابة القديمة، فمفهوم الكتابة لديهم لا يستوعب تقنيات الكتابة الجديدة واشتغالاتها. فقط ثمة اشتغالات أخري هي ما تمثل أكبر هاجس لدي بعضهم منها كما تقول مني سلامة بأنها »لن أكتب أبدًا ما يخالف عقيدتي، ولن أكتب بأسلوب وتوصيف أرفض أن تقرأه ابنتي» فهدف الكتابة ذاته غائم وغير محدّد، فهي من الأساس غير منشغلة من وراء الكتابة بــ »تقديم رسالة أو مناقشة قضية» سواء أنها تجد في الكتابة »روحها ومصدر سعادتها» فالكتابة علي حدّ قولها »تسعدني وتريحني وفيها دوائي إنْ لم أكتب فستظل تلك القصص تدور برأسي، حبسها علي الورق يحرِّرني» (موقع إضاءة: شمس محمود، مني سلامة: »ذات القلم: الحجاب لا يعني الغياب») وتلخص ياسمين حسن مفهومها لكتابة الرواية بقولها »يعني أنني أخلق مجموعة أحداث، وشخصيات. وإذا خلقتهم علي هيئة ملائكة لا يخطئون، ولا يرتكبون آثاماً وذنوباً، فسأكتب رواية مزيّفة وتافهة وأكذوبة كبيرة» (مهدي مبارك: »ماريا»… كيف تكتب روائيّة منقّبة مشاهد ساخنة؟ موقع رصيف الإليكتروني). وهناك مَن يجعل من الكتابة أداته علي خلق عالم خاصّ يتجاوز به قُبح العالم الواقعي كما فعل أحمد خالد توفيق في »يوتوبيا»، أو تلك العوالم التي يُقدّمها حسن الجندي من فنتازيا بعيدة عن روايات الرعب البسيطة التي مازالت المؤسسة العربية للنشر والتوزيع تصدرها.
أعادت وفاة الدكتور أحمد خالد توفيق المفاجئة رائد أدب الناشئة ظاهرة أدب الظل في مقابل الأدب الرسمي، إلي ساحة الجدال والنقاش من جديد. فما أن أُعلنت وفاته، حتي ثار الجدل حول القيمة الأدبيّة لأعماله باعتبار أن أعماله لا تنتمي إلي الأدب الرسمي المتعارف عليه، ومن ثم تنتمي إلي أدب الظل الذي لا يحظي باعتراف مؤسّسة النقد الرسمي. وبناء عليه انقسم الشأن الثقافي إلي فريقين فريق يري في الرجل أنه عرّاب الثقافة، أو الأب الرّوحي للشباب الذي أخذ بيدهم إلي القراءة، بأعماله البوليسية تارة والفنتازيا تارة أخري وما وراء الطبيعة تارة ثالثة وقد أخذ هذا الفريق علي المؤسسة النقدية تقصيرها في تناول ودراسة هذه الأعمال، وفقًا لمفهوم النقد البسيط، المتمثل في تتبع وتحليل الآثار الأدبية، والتعرُّف علي عناصرها ومن ثم إصدار حكم عليها إذا كانت هذه الآثار جيدة ومدي مبلغها من الإجادة، وهو الأمر الذي لم ينشغل به نقاد المؤسسة النقدية، حتي أنهم لم يعتنوا بتفسير معايير الأدبية التي جعلتهم يخرجون هذه الأعمال من دائرة اهتمامهم. أما الفريق الثاني فكان علي النقيض وراح يتساءل في غمز ولمز أقرب إلي انكار أدبيته ومكانته التي حظي بها عند الشباب، متسائلا: عمّن يكون أحمد خالد توفيق الذي واكبت وفاته حالة من الحزن العام، لدي قطاع عريض من الشباب؟ وبهذه التساؤلات كأنه يجرد هذه الكتابات من أدبيتها.
في نموذج أحمد خالد توفيق كان يستهدف شريحة معينة من القرّاء، ولم يَدَّعِ أنه تخلّي عن أهدافه في كتاباته، فالقرّاء أو الفئة التي ينشدها في رواياته سواء في سلسلة ما وراء الطبيعة أو روايات الرّعب أو الخيال العلمي حاضرون. كأنه يتمثل لمقولة روبير اسكاربيت »أن الكاتب الناجح هو الكاتب الذي يعبر عمّا تنتظره الفئة الاجتماعية، ويكشف هذه الفئة أمام نفسها، إن الانطباع لدي القرّاء بأنه خطرت لهم الأفكار نفسها أو أحسُّوا بالمشاعر ذاتها، وعاشوا الطوارئ نفسها، هو واحد من الانطباعات التي يذكرها غالبًا قراء كتاب ناجح». مقابل هذا القارئ هناك القارئ المثالي الذي يستهدفه الأدب الرسمي فوفقًا لياوس ومدرسة كونستانس حيث يتوقفان عند القارئ المثالي: »فالجوانب الأسلوبيّة والبلاغية للنص، يمكن أن تفترض قارئًا معينًا أو ضمنيًا؛ قارئًا يقع في أفق الانتظار». في ظل هذه المراوحة بين القبول وعدم القبول، ثمة طرف يعوّل عليه كُتَّاب هذه النصوص دون الاعتداد بمسألة النقد أساسًا، ألا وهو الجمهور. ومع أن جمهور الكاتب الذي يعوّل عليه يختلف اختلافًا جذريًا عن جمهور الناشر أيضًا، إلا أنه في مثل هذا النوع من الكتابات أو ما يمكن وصفه بأنه أدب خارج التصنيف وفقًا لمصطلح نُقّاد النظرية الأدبية، فإن جمهور الكاتب والناشر لأوّل مرّة يلتقيان. وإن كان جمهور الناشر كما هو معروف مقسوم ومتشّعب إلي فرق اجتماعيّة، وعرفيّة ودينيّة، ومهنيّة وجغرافيّة، وتاريخية، ومدارس فكرية، وجماعات أدبيّة أيضًا وفقًا لقول اسكاربيت إلا أنه في مثل هذه الكتابات هو جمهور موحّد ينتمي إلي طائفة واحدة. والكاتب يغازل قيمًا معينة داخلها، علي نحو ما تفعل روايات الرعب والبوليسية وكذلك الروايات التي يحرص مؤلفوها علي بثّ قيم داخل المجتمع، والأخيرة قد تلبست لبوسًا دينيًا في بعضها وفي بعضها الآخر أخذت تناقش قضايا خاصة بالمرأة علي نحو ما فعلت ياسمين حسن في رواية »ماريا» التي كانت تناقش مشاكل المرأة المغتربة خاصة إذا كانت زوجة ثانية. ومن ثمّ وجدت شريحة كبيرة من الفتيات والمراهقات ضالتها في مثل هذه الأعمال. ولنا أن نتأمل عناوين هذه الروايات لنري كيف أخذت تستقطب جمهورًا ذا إيديولوجية معينة، فتطرد أسماء روايات مثل: في الحلال، رزقت الحلال، أبغض الحلال، المنتقبة الحسناء، وقالت لي، غزل النبات، في قلبي أنثي عبرية، اغتصاب ولكن تحت سقف واحد، اكتشفتُ زوجي في الأتوبيس، عرسنا في الجنة، كوني صحابية، الرجل ذو اللحية السوداء، روح وريحان، وغيرها الكثير والكثير من أعمال تعزف علي الوتر الدينيّ، وتؤكّد علي أهمية العلاقات ولكن أن تأتي في إطار شرعيّ. ومن ثمّ تسربت إلي جيل من شباب تغذت أفكارهم وعقولهم علي الدّعاة الجدد من شيوخ الفضائيات كعمرو خالد وأسامة حسني، وغيرهما مِن دُعاة تبنوا خطابًا وعظيًّا، وإنما – كما يقول سعيد بنكراد في مسالك المعني اختاروا سبيلاً آخر يعتمد علي المحبة وهو أقرب إلي »أسلوب قصصي أداته المثلي في النصح والتنبيه والتوجيه والتحذير، هي سرد حكايات تعيد صياغة حياة ماضية تقود حتمًا إلي بلورة »قواعد للفعل» إضافة إلي خطاب المحبة». وهو ما اعتمدته الكاتبات فمعظمهن لا يقولن لا للحب، بل علي العكس، هن يدعون إليه ويشجعنه ولكن داخل إطار المؤسّسة الزوجية أي أن يكون »في الحلال» كما تدعو رقية طه، أو أن تفتخر الفتاة به فتعلن بفخرٍ »رزقت الحلال» كما هي رواية سارة محمد سيف، إلي أن تتحقّق أهم الغايات بأن يكون »عرسنا في الجنة» كما يدعو عزام حدبا.
الحقيقة التي لا يجب التغاضي عنها أن ثنائية الأدب الرّسمي وأدب الظّل، ليست جديدة علي الأدب. وإنما هي مُتحقّقة علي كافة المستويات وعلي مُختلف الأزمنة، بل تمتد لتصل إلي بداية نشأة الرِّواية العربية الحديثة، وما اكتنفها من صراع بين الرواية الشعبية التي نشأت في ظل حركة الترجمة التي كان لها تأثيرها الكبير في نشأة الرواية الفنيّة في طور البديات، علاوة علي دورها في هذه الفترة كمرحلة ضرورية في تحديث الأدب الخيالي العربي. وإن كان وضعها الدكتور عبد المحسن طه بدر في إطار روايات التسلية والترفيه. ولا يختلف هذا التوصيف بعيدًا عن تفرقة الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه »الأدب وفنونه» بين الأديب العظيم والأديب التجاري. فالأوّل عنده يستطيع أن يؤثّر في مجتمعه، وأن يكسب رضاه، دون أن يخضع لإرادة هذا المجتمع، بل ربما يستطيع تحقيق ذلك، وهو يقف معارضًا للمجتمع، في حين أن الأديب التجاري »وحده يتملّق الجماهير، ويخضع لها، ويترك لها إرادته تذوب في إرادته»، وبناء علي هذه التفرقة؛ فالأوّل أكثر تأثيرًا في المجتمع لأنه يؤدِّي دورَ الأديب الحقّ في مجتمعه، في حين الثاني وفق لعبارته الصّارمة »لا يمكن أن يكون عامل دفع في مجتمعه؛ لأنه سيترك المجتمع يدور في نطاق ذاته». وفي مرحلة لاحقة ناقش الدكتور جابر عصفور الظاهرة تحت مسمي الرواية الرسمية والرواية الرائجة، والدلالة المقصودة في المصطلحين لا تختلف عن المعني الذي أشار إليه عز الدين إسماعيل في تفرقته بين الأديب العظيم والأديب التجاري، بل إن المصطلحين في الأصل، تحوير لمصطلحي عز الدين إسماعيل إن شئنا الدقة. وهذا التاريخ الطويل من الرفض يكشف لنا أن الصّراع ظلّ وما زال قائمًا، في جدلية مثيرة، لم يخمدها توتر الزّمن أو حتي التوترات السياسية أو الاجتماعية. فلا النُّقاد يعترفون بهذه النوعية من الكتابات التي جاءت كاستجابة للتحولات الاجتماعية والثقافية التي حلّت وفقًا للتبدلات السياسية والإيديولوجية، وهيمنة خطابات القمع والاستلاب وفقدان الهويات وظهور الهامش الاجتماعي بعد الامتداد السرطاني للمدن العشوائية، وانسداد الأفق بتفاقهم الأزمات الاقتصادية وانتشار البطالة بين الشباب خاصة المتعلمين منهم، وهي الثيمات التي راحت تطرد في معظم النتاجات الروائية، في تأكيد علي حجم المعاناة التي يُعانيها الجيل الجديد الذي تفاقمت أزمته عمّا سبقه من أجيال، بعد خيبات سياسية وأزمات إقليمية هزت الثوابت وعرّت خطابات الهيمنة الزائفة، ففرّ فريق منهم من الروايات الرسميّة التي تسعي لتجسيد هذه الأزمات المتتالية، إلي عالم الخيال واليوتوبيا الذي صنعته كتابات أحمد خالد توفيق، وبعضهم وجد الملجأ والملاذ في هذه الصور النمطية الاستهلاكية التي راحت تتكرّر في روايات الفتيات بشقيها الدينيّ والاجتماعي الرومانسي، كبديل أولاً من الهروب من جحيم الواقع الذي بدت فيه الغلبة لكلّ ما هو غربي، بإعلاء كل ما هو عربي / شرقي في إعادة لثنائية الغرب والشرق، الآخر / والأنا. والغريب أن معظم هذه الكتابات كانت تنتصر لكلّ ما هو عربي / شرقي علي حساب الغربي، في تلفيق وابتسار للحقائق المؤكّدة بعدما صار هذا الآخر الذي هو في خطابها يحمل صفات؛ المستعمر والمحتل والظالم والعدو، هو الملاذ الآمن الذي راحَ يحتمي به هذا الشرقي والعربي بعدما اتّسعت حالات اللجوء والهروب من الأوطان، لدرجة أن مني سلامة في رواية »من وراء حجاب» تبدو وكأنها تناصب العداء لكلّ مَن يخالف اليقين المطلق السّائد عند الأصوليين، وهذه الإيديولوجية ربما كانت دافعًا لأن تتغني هاجر عبد الصّمد بهذا الفكر فتعلن كما هو عنوان روايتها »حبيبتي داعش» وهي رواية في مجملها ترسخ لفكر الهيمنة الذي تتبناه هذه الجماعات الأصولية ومحاربة ونفي الآخر وإقصاء لكلٍّ مَن يخالف تصوراتهم، ومن طرف تسعي لتقديم مبررات لما تفعله هذه الإيديولوجية الأصولية بإظهار الشخصيات جميعها وهي مشوّهة »نتاج قهر السُّلطة لأفراد المجتمع، وتعايش الأفراد مع هذا القهر الذي يلاقونه لا مواجهته» كما تقول أماني فؤاد (الثقافة الجديدة، ص 13). وثانيًا يأتي الهروب إلي هذه الكتابات كنوعٍ من الاحتماء بما تبثّه مِن قِيَّمٍ مُفْتقَّدة أو غائبة، في ظل صراع إيديولوجيات متناقضة، استطاعت الدينية منها أن تفرض سطوتها وتستحوذ علي قطاع عريض من فكر الشباب، علي الرغم من تناقض مَن يحملها أو يسعي إلي ترسيخها.
سواء علي مستوي الدُّعاة الجدّد، أو حتي علي مستوي الكتابة نفسها، فياسمين حسن صاحبة رواية »ماريا»، والتي تنشر صورتها كمنتقبة، وتفتخر بأصوليتها هكذا »منقبة وأصلّي لكن لا أتحدَّث عن عقيدتي، وأخطّط للسفر حول العالم، وأريد الاستقلال عن أسرتي والهروب من سلطة الأب. لا أعرف عن السلفية والإخوان أيّ شيء. أقرأ القرآن… منقبة ولا أرتدي جوانتي يخفي يديّ، ولي أصدقاء رجال. مقتنعة بالنقاب، وأكتب روايات» تعترف أنها لا تكتب إلا وهي »متجردة من كل ملابسها» ووفقًا لشهادتها أنها: »أكتب وأنا عارية حيث أبدأ الكتابة وأنا لم أزل في فراشي، وغالباً لا أقدر علي الكتابة إلا إذا خلعت كل ملابسي واستمعت للموسيقي، وأتوقف حين تعود لي سكينتي بعد تفريغ شحنة حزن، وأول ما أنتهي، أتوضأ لأصلي الصبح، مشيرةً إلي أنَّ الكتابة رزق، وأنها تؤمن بأن الله يوزّع الرزق أوّل النهار، لذلك تبدأ مبكراً لأخذ حصتها».
وهو ما يكشف خللا كبيرا في هذه الظاهرة، يتمثل علي حدّ قول أماني فؤاد »في تناقض فعل الكتابة وطبيعة ذهنية منتجته وكاتبته بصورة كاملة» وهذا التناقض بمثابة سؤال مفتوح عن أسباب هذا الانقسام بين شخصية الكاتبة والشخصية الذاتية؟!.
قابل موقف النقاد الصَّارم ضدَّ هذه الكتابات، موقف الكتاب أنفسهم، وهو لا يقل صرامة وجمودًا عن موقف النقاد حيث رفضوا أن يتنازلوا عن هذه الصيغة الوعظية المبطنة في أعمالهم بما تتضمنه من آيات قرآنية وأحاديث شريفة، ومواقف من حياة الصحابة، وما يقابله من إظهار تشوهات المجتمع وحالات الفساد وهو ما يشي بخلق رؤية سوداوية لهذا المجتمع، وراعوا أدب القيمة الذي يدعوهم إليه النقاد بتعبير الدكتور عصفور، حيث هو المعيار الفاصل بين ما يكتب هؤلاء الكُتَّاب، والرواية الرسميّة التي لها ممثلون كنجيب محفوظ وتوفيق الحكيم وبهاء طاهر وإبراهيم عبد المجيد وإبراهيم الكوني وإميل حبيبي وعبد الرحمن منيف … إلخ من نماذج وقامات في الروايات التي يجعل النُّقَاد مِن أعمالهم معيارًا للمفاضلة في تمثيل الأدب الرفيع، والأهمّ أنّ القرَّاء أنفسهم لم يقتنعوا بما ذكره النُّقاد عن القيمة والأدب الرفيع.
تفسير الظاهرة سيوسيولوجيا
في أحد التفسيرات المهمّة للنجاح التجاريّ للرواية الشعبية – في الماضي – أرجع الدكتور عبد المحسن طه بدر في دراسته: »تطور الرواية العربية الحديثة» السبب إلي »نمو التعليم الجماهيري وصعود جمهور من القراء شبه المتعلمين الذين اضطروا إلي الهرب من واقع الاستعمار السياسي والاجتماعي»، لكن هذا التفسير لا يمكن أن يتطابق مع روايات الخيال العلمي أو الرعب أو حتي روايات البنات ذات الطابع الرومانسي أو الدينيّ التي تتبني قيمًا في المجتمع انتشرت في الآونة الأخيرة وشكَّلت ما يُسمي بالظاهرة سواء علي مستوي سوق النشر أو علي مستوي المقروئية، أو ما عرفت باسم »روايات المنتقبات» كما هي عند الدكتورة أماني فؤاد وإن كان المصطلح الذي استخدمته إشهاري ويحمل صبغة إيديولوجية تكريسية رفضتها الناقدة وبمعني أدق استهجنتها علي كتابات الأديبات ووصلت السخرية إلي الاستهجان من النقاب ذاته فعلي حدّ قولها »لا يتسق فعل الكتابة مع يد مخبأة خلف قفاز أسود؛ خوفًا من أن تلامس العالم أو يلامسها هو»(الثقافة الجديدة، عدد أبريل 2018، ص 11). فمع أن ثمة روابطَ مشتركةً تجمع بين النوعين؛ الروايات الشعبية (التي نشأت مع بدايات عصر النهضة) وروايات أدب الظل (ويمكن وصفها بأنها روايات شعبية حديثة) أو الروايات الرائجة بتعبير جابر عصفور؛ حيث التسويق والجمهور العريض من القراء، بما يشبه التنازع بين المـُنتَج له (فئة القراء) والناشر لها، بما تحقّقه هذه الروايات من نسب توزيع عالية خاصة لاستقطابها فئات عمرية معينة إلا أن الفارق المهم أن سبب النشأة قد اختلف عمّا ذكره عبد المحسن طه بدر، فجمهور هذه الروايات الشعبية الحديثة، ينتمي إلي طبقات اجتماعية متنوعة تحظي بقدر كبير من التعليم يصل إلي الجامعة، كما أنهم يمتهنون مهنًا مختلفة تتجاوز بكثير الحرفيين والصناّع الذين كانوا جمهور الروايات الشعبية في بداية عصر النهضة.
نرشح لك: بالصور.. توقيع ومناقشة “حكاية مصرية” لـ جودة عبد الخالق وكريمة كُريم
فهذا الجيل الجديد يختلف جذريًّا في النشأة والتكوين وأيضًا في الوعي عن الجمهور الذي قصده عبد المحسن طه بدر. ويكفي أن صمود هذا الجيل بوعيه المنقسم بين إيمانه بذاته وحبه لوطنه رغم حجم الإكراهات التي يفرضها هذا الحب عليه، وقوميته التي لم يعد منها سوي ظلال أغنيات تتردد في مناسبات علي استحياء، بعدما تشعبت وتشتت أركان هذه القومية، باحتلال الجارة العراق للجارة الكويت، ثم انقسام السودان إلي شمالي وجنوبي، وهو ذات المشروع الذي يواجه ليبيا وسوريا واليمن في ظل أزمة صراع علي السلطة في هذه الأقاليم.
لذا فقد الثقة في السياسة خاصة بعدما اكتوي بجحيم الانتكاسات العربية وهزائم الأحلام، فَبَعُدَ عن التأطير، رافضًا أن يكون ضمن النسق، أو النمط المؤدلج.
بل يسعي إلي مَن يُعبّر عن احتياجاته ويستوعبها لا من يصدر له الأوامر، بعدما فقد الثقة في التنظيرات المغرقة في الأوهام، ومن ثم كان الاهتمام المبالغ بكتابات علاء الأسواني بما تحمله من إيديولوجيا معارضة للسلطة وهو ما وجد هوي لدي هذا الجيل الذي يقف ضدّ هذه السلطة أو علي الأقل مع مَن يعارضها لأنها لا تعبر عنه. وإن كان ثمة تفسير لانتشار الرواية الرائجة عند جابر عصفور لا يختلف عن تفسير عبد المحسن طه بدر، مع اختلاف الوسائط الجديدة التي حلّت، ولعبت دورًا مهمًّا في تغير الجمهور نفسه. فعصفور يري أن تناميها يرجع إلي وجود »ذائقة جديدة لقرّاء يُؤثرون السُّهولة، ويميلون إلي التشويق في سِياقٍ ينطوي علي التوابل المألوفة»، الغريب أنَّه يلجأ إلي توصيفهم مثلما فعل عبد المحسن طه بدر من قبل بأنهم ينتمون إلي طائفة الحرف المهمَّشة والطبقات الاجتماعية المتوسطة، هنا جابر عصفور يقول »ولا أستغرب لو كان أصحاب هذه الذّائقة من مُدمني الفيس بوك والمواقع الإلكترونية التي تُعطي كمًا لا نهائيا من المعلومات والمشهيات القرائية، ولكنها لا تُعطي فكرًا نقديًّا، ولا نوع المثقف الذي يعرف الفرق بين قراءة التسليّة العابرة وقراءة المتعة الفنيّة عميقة الأثر».
> > >
مع هذا التعنت في الاعتراف بهذه الظاهرة من قبل المؤسسة النقدية، إلا أن ثمة أفرادًا ينتمون إلي هذه المؤسسة تبنوا الاعتراف به، وإن كان علي محدودية علي نحو ما فعل يحيي حقي. عندما نشر في عام 1970 ما يعد احتفاءً بموهبة شابة متمثلة في شخصية إسماعيل ولي الدين وروايته »حمام الملاطيلي» التي اعتبرها حقي »ردّ اعتبار للرواية المصرية التي تحكي عن الأحياء الشعبية، بعدما اتهم أستاذًا فرنسيًّا متخصصًّا في الأدب العربي شارل فيال، بأنه وصم الأدباء المصريين بأنهم لا يكتبون عن الأحياء الشعبية المصرية». فوصف حقي »حمام الملاطيلي» »بأن المؤلف مغرم صبابة ومتيم ومسحور ومجذوب ومحب للآثار الإسلامية.» وإن كان ما نشره حقي أثار حفيظة البعض فقدّم الكاتب أحمد أبو كف في نفس المجلة، قراءة عن هذه الرواية، وكتب في مقدمة الموضوع: »لنترك أعمال نجيب محفوظ شاهقة الارتفاع، فهذا الهرم الروائي قد لا يجود الزمان بمثله، لنتركه في قمته، ونذهب بأقدامنا إلي مؤلف جديد شاب اسمه إسماعيل ولي الدين، عاش داخل حمام الملاطيلي بحي الجماليّة، خالط ناسه من الطبقات الدنيا واستوعب لغتهم وعاداتهم وغاص في نخاع طباعهم واقترب من الأرض في علاقته بهم، بل إنه نزل معهم وعاش وسط ضباب الحمام الشعبي بعد ذلك.(راجع: محمد السرساوي: »الأخبار» تبحث عن الأديب الذي غاص في القاع، أين اختفي مبدع »الباطنية» و»السلخانة» و»حمام الملاطيلي»). نفس قدر الاهتمام الذي أولاه يحيي حقي لمثل هذا النوع من الكتابة، فعله الدكتور سيد البحراوي مع رواية »ربع جرام» لعصام يوسف، وهي الرواية التي اعتبرها جابر عصفور ضمن الروايات الرائجة، لأنها لا تحمل »رؤي عميقة للعالم في بنية فنيّة متميزة» كروايات أحمد عبد اللطيف وطارق إمام.
وتأتي دراسة الدكتورة أماني أحمد فؤاد التي نشرت في عدد أبريل 2018 من مجلة الثقافة الجديدة تحت عنوان : »النص الروائي: وثيقة إيديولوجية – سيوسيولوجية، حول رواية المنتقبات» لتكون أولي الدراسات من جانب ناقدة أكاديمية أخضعت فرعًا من الظاهرة للدرس والتحليل، وإن غلب علي الدراسة تبني إيديولوجيا معارضة لفكرة كتابات المنتقبات ذاتها، كما أن الدراسة علي ريادتها وأهميتها، لم تتوقف في جزء منها عند دراسة أسباب نشأة هذه الظاهرة، وأسباب انتشارها أوساط الشباب، والأهم أنه غلب التوصيف للأعمال العشرة التي خضعت للدراسة، وغاب التحليل الفني والتقنيات إلا في إشارات عابرة. كما أغفلت الكاتبة عن عمد روايات لكاتبات أكثر نجومية كدينا عماد وخولة حمدي، والسبب أنهن لا يرتدين النقاب، وإن كانت كتاباتهما هي الأخري حقّقت جماهيرية عريضة، خاصة في ظل هذه التوليفة التي تعتمدها الكاتبات، فتركز دينا عماد علي قصص اجتماعية وبعضها رومانسي، ويكفي أن نتأمل عناوين بعض أعمالها لنكتشف الرسائل التي تحملها هذه الكتابة ومنها: »لست عذراء، ليلة حمراء، تحت سقف واحد، حبّ ملعون، هل يشفع الحب، الحب علي كفة، قلب أجهده العشق، وغيرها من أعمال تعزف علي هذه الوتيرة من عناوين الإثارة والفجيعة، وبالمثل عناوين خولة حمدي: في قلبي أنثي عبرية، وغربة الياسمين وأين المفر؟.
وهو ما يعيد إلي الذاكرة ظاهرة أديب الشباب التي تمثلت في شخصية محمود عبد الرازق عفيفي، في الثمانينات من القرن المنصرم. وكانت كتاباته التي كان يروج لها بوسائل غير تقليدية بكتابة إعلانات علي الجدران وأسفل الكباري وملاعب الكرة ومحطات المترو والقطارات. أو عبر العناوين المثيرة التي كانت بغرض جذب المراهقين في الأساس كانت توزع أكثر من أديب نوبل نجيب محفوظ. الجدير بالذكر أن ظاهرة أديب الشباب اعتبرها الدكتور محمد بدوي ظاهرة موجودة في كل الأزمان، بل ويصفها بدوي بأنها »خير معبر عن ذلك الأدب غير الرسمي، الذي لا ترضي عنه السلطة (دينية / أدبية / سياسية). فأديب الشباب كما يراه »بدوي» بطل في دنيا الهامشيين الذين لا صوت لهم، القابعين خارج المتن، الباحثين عن تسلية بسيطة، فكاهة، شخص يتحدث مثلهم دون تقعير أو عبارات خلابة »اللي شبهه طول الوقت بيوصل للناس ع القهاوي وفي الأتوبيسات».(تحقيق موقع مصراوي بعد 20 عامًا أديب الشباب يخرج من عزلته).
قد يدخل تحت هذه الكتابات أسماء حققت شهرة عريضة خلافًا لأحمد خالد توفيق، فكتابات علاء الأسواني منذ »عمارة يعقوبيان» وصولاً إلي جمهورية »كأن»وهي تغازل الجماهير، وبالمثل كتابات أحمد مراد وإبراهيم عيسي، فوفق معايير المؤسسة النقدية الصارمة تدخل في هذا الإطار، وإن كانت كتابات الأخيريْن تسللّت إلي القائمة القصيرة لجائزة البوكر، والمفاجأة أن لجان التحكيم في المرتين اللتين دخلت فيهما أعمال أحمد مراد وإبراهيم عيسي، ضمّت أعضاء ينتمون إلي المؤسسة النقدية الأكاديمية التي تتميّزُ بالصَّرَامة في قَبول هذه الأنواع، بل تُصرُّ علي وصفها بالروايات الرائجة، كنوعٍ مِن التقليل لها وليس المــَدح، علي الرغم من أنَّ الرَّوَاجَ في البلاد الأخري يحتوي علي القيمة كما ذكر جابر عصفور نفسه، فيكفي التذكير بأن روايات أورهان باموق وأليف شفق التركييْن تتجاوز الطبعة الواحدة حوالي 200 ألف نسخة، دون أن يُقلِّل أحد من كتابات أي منهما علي مستوي القيمة الفنية، رغم أنها تدخل وفقًا لقوائم البيست سيلر، في ذات القوائم.
الخلاصة،بما أنالأدب »نوع خاص» من اللغة وفقًا لرأي الشكلانيين، فكما يقول رومان جاكوبسون إن الأدب يحوِّل »اللغة الاعتيادية، ويشدّها، وينحرف بصورة منظمة عن الكلام اليومي»، وفي كل ما تقدّم من محاولات، يُمارس الكُتّاب ألاعيبهم بواسطة اللغة وانحرافاتها. لذا، يصعب أنْ نُقْصِي أيّة كتابة عن الأدب،فما يقرأه أحد علي أنه ليس أدبًا يقرأه آخرون علي أنه من الأدب فكما يقول إيجلتون »الأدب خطاب غير ذرائعي»، فيخلص إلي أنه ليس للأدب جوهر مهما يكن هذا الجوهر، ويمكن لأية قطعة من الكتابة أن تقرأ بصورة غير ذرائعية، إن كانت »غير الذرائعية»تعني ما يقرأ النص بوصفه أدبًا. ومن ثمّ فالإقصاء في حد ذاته ضدّ الأدب، فمقولة الأدب ليست موضوعية في حد ذاتها، وهو ما يعني أنها ليست أبدية ولا تقبل التغيير، ما دام هناك ذائقة متغيرة، ومن ثم المعيار الأساسي هو الجمالية، التي تختلف بين كتابة وأخري.
ووفقًا لهذه الجمالية والميول نحوها، تنتج كتابات نخبوية وأخري جماهيرية، والمعايير التي تنظر بها النخبوية إلي الأدب بالطبع تختلف عن المعايير الجماهيرية، وهو ما خلق تعدد في الأذواق وخروج كتابات كسرت حد الاحتكار علي نحو ما فعلت كتابة هاري بوتر التي صنفتها المؤلفة إلي فئة عمرية صغيرة لكن طغت شهرتها علي الجميع، وبالمثل أعمال دان براون.
كما لا ننسي الشرط التاريخي والثقافي الذي يلعب دورًا مهمًّا في الترويج لأعمال بعينها. وما قيل عن الروايات الرائجة أو الشعبية أو المنتقبات وغيرها من مسميات تقع تحت دائرة الظل أن هذه الأعمال يكفيها أهمية أنها غيرت سوق الكتب وساعدت علي الرواج؛ لدرجة أن كُتَّاب الثقافة الرفيعة عبروا عن شكاواهم المريرة عن شعبيتها ورواجها التي تتأثر بالنقد، والتي لا تستحقها». وبناء عليه أن يعود النقد لوظيفته التي ارتآها إدوارد سعيد بأنه مطالب بالكشف عن الوظيفة الثقافية والإيديولوجية للنصوص الأدبية، بدل العكوف علي فحص قيمه الجمالية».
ولا أدل علي اختلاف هذه الذائقة من اختلاف رد الفعل حول حصول الكاتب أحمد مراد علي جائزة التفوق لهذا العام، التي تمنحها الدولة المصرية، متخطيًّا كُتابًا لهم مكانتهم المشهودة في عالم الأدب، وكذلك لهم مشوارهم الطويل في عالم الأدب. وهو ما يؤشر إلي بداية عصر هيمنة أدب الظل، وتفوقه علي الأدب الرسمي بلغة النقاد الأكاديميين! فهل سيقبل نقاد المؤسسة بهذه التصنيفات أم جاءت جائزة أحمد مراد كنوع القنطرة التي يتم عبور بها هذا الأدب وقبوله ضمن الأدب الرسمي؟.