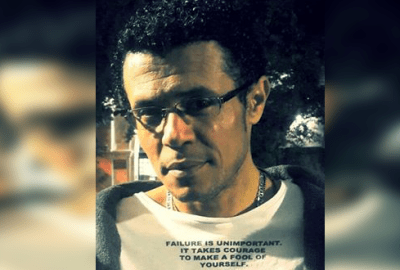في الخيال.. قصة لـ حازم متولي
الدنيا مقلوبة على جانبها من وجهة نظره وهو مُلقاً تحت سلم المشاة لكوبري 15 مايو على كورنيش مسبيرو، الحركة ساكنة والليل في ساعته الأخيرة، كان قد فتح عينيه للتو من غفلة ثقيلة، ولا يكاد يستوعب وضعه الغريب، حتى يرى في البعد على الرصيف المقابل حشدا غير منطقي من النساء، نساء مبهرات من فرط الروعة في كل الهبات، الجمال والأنوثة والغواية والألوان وكل ما يخطر ولا يخطر من محاسن النساء ونِعَمها في الخيال، 20 أو ربما 30، يأتينه عابرات نهر الطريق كأنما تتوالى خطواتهن على الهواء، وفي تلك المسافة كان قد اعتدل في وضعه جالسا فاعتدل وضع الدنيا في عينيه، وفي تلك المسافة أيضا، أصبح الطريق جدولا تأتيه النساء قفزا على سطح مياهه المتلألئة، بينما لم يعد يرى العمائر البالية لهذه المنطقة من الكورنيش، بل بساط مروج أرجوانية اتسع إلى ما لا نهاية، وستائر هفهافة شفافة تدلت من طاقات نور في صدر السماء السابعة حتى كادت تلامس أطرافها الأرض وهي تتراقص بدلال مع نسمات تهدهد كل هذا الجمال، أما النساء، فقد أتين تجذبنه وتصعدن به سلما من أحجار الفيروز تنتهي قمته بعرش أبيض تشكل من طواويس بيضاء تنفش ذيولها بخيلاء، وحين استقر على عرشه وأطل من عليائه كانت النساء تمرحن في الأنحاء التي تتبدل كأنما تتبدل خلفيات الوجود، تتطارَدن في غابة زهور، ترقصن في واحة نخيل، تبنين بيتا من الأصداف والشعاب المرجانية على شاطئ في الكاريبي بانطلاق متوهج، ثم تتوالين بمرح قافزات من مصب شلال ينبثق من قمة جبل جليدي، لتغطسن في ماء نهر تحف ضفتيه قصورٌ في طرزٍ من كل العصور والأمصار، تخرجن من الماء لامعات جاريات كقطيع غزلان إلى بوابة قصر مهيب، يضج بهوه بصخب وأضواء ملهىً فسيح ومسرح عرض ماجن تتوالى عليه نساء هذا الفردوس، بينما يشاهد الاستعراض من علياء عرشه الذي اختُصرت درجات سلمه إلى 3 فاقترب دون أن يفقد هيبته.
هكذا تكون تلك الرؤيا حين يستسلم للنعاس في كل ليلة منذ شهور مضت لا يذكر لها عددا، حلم بديع، أليس ما يراه هو الجنة كما يصفها من يلقون بأنفسهم في التهلكة من أجلها، لكنها تأتيه مجانا، تملأ نصف ليل سباته نشوة، ثم تحول نصفه الثاني لجحيم بعد وصولهن به لهذا الملهى، يحدث ذلك حين تجتمعن على المسرح في نهاية العرض، ويتصاعد الصياح والتصفيق حتى يتفاقم فاقدا نشوته نافخا في الأذن طنينا مدويا شديد الإيلام، ثم تحين الطامة الكبرى، حين تنتخبه النساء من بين كل الحضور قافزات كالفراشات في فضاء الملهى وتهبطن بإشارة ممن تقودهن كلاّ في مكانها وقد أحطنه في نصف دائرة، ثم تقتربن منه بكل ملامح وإيماءات الغواية مجتمعات.
في الاقتراب، يَهُبُّ خليط عطورهن الشرقية والغربية المركزة، يتشبع الهواء بذلك العبق الثقيل الخانق من مزيج العود والمسك والعنبر والورود والتوابل العطرية حتى تختنق به أنفاسه إلى أن تنقطع تماما تحت وطأة العناق الجماعي الشبِق…
ينتفض مذعورا من ذلك الكابوس وهو يلاحق رئتيه بلهاث استعادة الصدر للحياة حتى يستقر يقينه بعودته للعالم الأرضي من جديد، فنجده يستقر تحت بطانية مهترئة في ركن من القاعدة الخرسانية لأسفل كوبري 15 مايو، ويكون الشروق في دقائقه الأخيرة.
يعيش في هذا المكان منذ زمن لا يذكره، هو لا يذكر تفاصيل اليوم الذي يمضي، كل ما يذكره هو أن النهاية قد عادت به سالما لمستقره بصحبة زجاجة نصف البراندي المَحلي وحباية الخيال التي يفضل أن يبدأ بها يومه التالي على الريق، يلقي بفارغ زجاجة الأمس خلف تكوين من كاويتش السيارات يحاكي الفوتيه، يخرج الحباية من جيب بقايا البنطلون الذي يرتديه محفوظة في ورقة ألومينيوم، يحل عنها الورقة ويبلعها مع جرعة ماء يغرفها بكفه من النيل ثم يلطم وجهه ببضع دفقات منه يزيل بها كسل الجفون.
يستلقي على حافة القاعدة الخرسانية محلقا في السماء لزمن لا يعلمه، ثم يبرح مكانه ويدلي ساقيه بحذر يتحسس حرارة ماء النهر، ينزل بتأن ويشرع في سباحة “كلابي” رائقة في اتجاه ضفة كورنيش مسبيرو.
يصل لحافة الشاطئ الرطب، يستلقي على ظهره مصدّرا بصره وابتلاله للشمس لزمن أيضا لا يعلمه، لكن الشمس كانت قد مالت للغرب قليلا مع ابتداء العصاري حين فتح جفنيه وقد جفت الهلاهيل، راميا ببصره يمينا ثم يسارا في لمحة استفاقة عفوية، وفي اليسار رآها.
حورية سخية دقيقة المنحنيات في عباية سوداء محبوكة، وشبشب بصباع من القش الملون، وإيشارب رقيق يطلق غرة وفيرة من شعر مجعد غجري ليليّ لامع كشعر خيل متعرِّق، تحمل حقيبة يد فضفاضة تبدوا غنية بمحتواها، تنتخب جانبا حجريا يطل على الماء خالعة شبشبها جالسة مدلية ساقاها فتلامس أطراف أقدامها صفحة الماء، ثم تشرع في إخراج ثِرمُس وكوب زجاجي حين تفاجأ به يقف على مسافة بضع أمتار منها على الشاطئ، ارتابت لوهلة، لكنها اطمأنت حين هدأ وقع المفاجأة وتمكنت من رؤية ابتسامته النقية، كانت نقية رغم هلاهيله وحفائه وامتداد طول شعره إلى ثلث ظهره ولحيته بشنبه يطمسان الكثير من هوية الملامح، لكنها اطمأنت لتلك الابتسامة حين قرأت نقاءها في عينيه.
دعته دون تحفظ ليشاركها كوب شاي، أخرجت كوبا آخر من حقيبتها ثم برطمان السكر الصغير والملعقة، جهزت كوبين وتركت له الملعقة ليضيف ما يشاء من السكر فكان ما شاء قد قضى على نصف البرطمان، تجاورا محلقان في الضفة المقابلة آخر صفحة النهر، أخرجت من الحقيبة علبة سجائر تحتفظ فيها بسيجارتين ملغومتين، أتت بواحدة وأعادت العلبة لقاع الحقيبة، ثم أشعلت السيجارة وتشاركا تدخينها.
تخبره أن اسمها ميادة، هي من حلوان، وهذه مرة قدومها الأولى للاختلاء بنفسها على هذا النحو قاطعة كل تلك المسافة، فقد اختارت أبعد النقاط عن احتمال ظهور معارف من أي جانب، خاصة معارف الجيرة، لديها دافع لذلك بالطبع، لكنه حين سأل بشأنه لم تفشِ به، إلا أنها كانت تتمنى ألا تقضي تلك الفسحة من الاختلاء وحيدة، وجدت نفسها وهي تعد حقيبتها لهذا اليوم أنها تضع كوبا إضافيا، وتلغم سيجارة إضافية، كأنها كانت تستعد للقاء غير مؤكد تطمح في أن يتحقق.
في الحقيقة، بدت ميادة غريبة، منذ اللمحة الأولى له وحتى انضم لها في هذه الخلوة الرائقة، بدت كأنها لا ترى هيأته على ما هي عليه فعلا، بالحتم هيأته مربكة ولو بقدر ما، قدر يستوجب الحيطة ولو في مرحلة التعارف، ناهيك عن كون تصنيفه من وجهة النظر العامة يعتبر “مريبا”، لكنها بدت وهي تتعامل معه كأنها لا ترى في مظهره أي شأن غريب أو ملفت، استقبلت ظهوره كأنما استقبلت صديقا قديما ظهر بعد غياب طويل، وضمته لخلوتها بعشم عشرة تطمئن لها الروح، وتحدثت وصارحت وحكت كأنما تلقي بأثقالها في بئر الأمان، إلا أنها لم تفشِ سبب قدومها.
لم يُعر هو بالا لما أخفت، أخبرها أن اسمه “سبيل”، وأنه لا يذكر من أين أتى، هو يعلم أنه قد أفاق من غفوة في العراء، وفي رحلته سيرا على طرقات السفر، لم يكن يدرك لنفسه وجهة، يمر بلافتات لكنه لا يفقه قراءتها، ثم استقل صندوق عربة ربع نقل بصحبة عدد من فلاحي إحدى مزارع الطريق الصحراوي، واستقرت بهم في رمسيس، هكذا عرف الاسم من السائق، وهكذا بدأ يعرف كل شيء في الحياة من جديد، وها هو يجلس بجوارها الآن وقد عرف لنفسه سكنا وأطلق على نفسه إسما وتعرف على العالم المحيط بما يوفر له طعامه وزجاجة مشروبه وحباية الخيال التي يستفتح بها أيامه.
قد يكون شخصا آخرا فيما انمحى من صفحة الذاكرة، لكنه يبدو متعايشا مع “سبيل” بما لا يوحي بفرصة لتغييره، وعليه، لم تعر ميادة بالا لما كان قبل أن يكون “سبيل”، لقد تمنت ألا تقضي خلوتها وحيدة وتحقق ما تمنته بحضوره، وهو حضور كان من وجهة نظرها وافيا.
مالت الشمس للمغيب، وانتبهت ميادة لجوعها، فقررت دعوة سبيل للغداء، أعادت الثِرمُس والأكواب والسكر في الحقيبة وغادرا، كان الصعود لسور الكورنيش أكثر عناء من النزول، وبادرت مياده بمسك يدِه ليدعمها ففعل وهو متوازن يحفظ كل نُقرة ونتوء، قفز السور وعاونها حملا حتى تجاوزته بسلام، وتمشيا على الرصيف يستقبلان ساعة الغروب بأنفاس رائقة وإيقاع خطو هادئ وأياد متشابكة.
كان مشهد نزهتهما جللا، هذا ما دار في خياله، هو على يقين بما يوحي به مظهره لعموم الناس، على يقين بحتمية أن يكونا في تلك النزهة محط الأنظار والأسماع، وأن تنتشر همهمات ومصمصة شفاه متحسرة على ذوق تلك الحورية العطِن، وتلقيح عبارات قبيحة قميئة بل لا مانع من محاولات تحرش جسدي سافل، إضافة إلى احتمال أكيد لتصويرهم بكاميرات التليفون ونشرها على شبكة الانترنت مصحوبة بعناوين هزلية متهكمة وضيعة لمضاعفة مشاهداتها، عرف الكثير عن تلك الشبكه من جلسات التسكع العشوائي في المقاهي، لكن أيا من كل تلك الاحتمالات لم يحدث، كانت نزهة رائقة، يمر من يمر كأنما يمر بأشباح غير مرئية، فلم يعد المحيط يشغل في محيط بالهما إنشا.
تحدثا في هذه النزهة عن الكثير، تحدث هو عن “سبيل” ورغد عيشه على هذا النحو المتصعلك، كان حين بدأ الحياة في ردائه لم يصل لهذا الحد من الاهتراء في مظهره، ولم يقض زمنا سوى بضع أسابيع يتسكع بحثا عن هوية أو كيان أو حتى مسكن يأويه، أنفق كل ما وجده متاحا من المال في جيبه عندما أفاق من تلك الغفوة في العراء، فقد استقر على اتفاق مبيت مدفوع الأجر في منامة يقيمها أحدهم في شقة تحت اسم “بنسيون”، من 6 لـ 10 مراتب في كل غرفة، كانت شقة أمه، لكنه يسكن في الشقة المقابلة لها مع عشيقة يشيع أنها زوجته، كان في عمر تجاوز الستين، وكانت هي في زهو نضج الثلاثين، سمراء بملامح مصرية السمات موروثة من أب بجذور صعيدية، تغلفها أنوثة جينات أم سواحلية تتنفس منذ الميلاد يود الاسكندرية المحفز لعشق لذة الحياة، وكان اسمها “عيون”، تلك الأسرار والتفاصيل لم يبحث عنها سبيل ولم يكن يشغل بها بالا، كان مسحولا في البحث عن وجوده، لقد أتته الأسرار على حِجرِه بعد دعوة منها على الإفطار، في تلك الأيام كان يستحم بانتظام، يغسل الثياب أسبوعيا على أقل تقدير، ويحلق ذقنه بماكينة “لورد” بلاستيكية.
كان مغادرا في الصباح على ألا يعود إلا للمبيت بعد التاسعة مساء كعادة كل صباح، يغادر لا يعرف لنفسه وجهة، لكنه لابد أن يفعل قبل التاسعة صباحا، في العادة، كان يبدأ اليوم بالمقهى القريب، يشتري إفطاره من عربة فول في الطريق ثم يستقر هناك، بعد بضع أيام بدى القهوجي في معاملته أكثر تبسطا، مما أشار إلى اعتباره زبون مكان، تعرف هناك على ما يسمونه “فيسبوك”، طلب من القهوجي تصويره بتليفونه ونشر الصورة على صفحته الخاصة مصحوبة بعبارة يدعو بها من يتعرف عليه للاتصال برقم المقهى، لكن لم يأت للمنشور رد ولو هزلي، كأنه خـُـلق حين أفاق من غفوته في العراء، كأنه أول قومه لا قوم له قبله ولا بعده، واليوم جاءته دعوة الإفطار فلم ينزل لتسكعه المجهول.
غادر الشقة في التاسعة إلا خمس دقائق فقابله باب شقتها مفتوحا، وكانت تجلس في عمق صالتها على كرسي طاولة السفرة الذي تكشف منه التحركات خارج الباب، لوّحت له في صمت أن يأتي، وكانت إشارتها ودودة بقدر يطمئن له، تردد بعض الشيء إلا أنها حين كررت إشارتها كانت أكثر حسما مع احتفاظها بنفس القدر الودود، فدخل.
ألقى التحية فردَّتها وهي تدعوه لإغلاق الباب بشكل أكثر عجالة ففعل، مأدبة إفطار مفتخرة، ثم انتقل المجال بعد شبع البطون لفتح الكوتشينة مع شرب فنجاني قهوة صنعتهما عيون بتأنٍ على السبرتاية، وألقت في كل منهما نصف حباية من ذلك العقار المعجزة.
عقار عجيب غريب، حين يكون اللغم بقدر نصف حباية، يكون الفجور مقصده، ولكن حين يتضاعف اللغم بقدر حباية كاملة، يكون الخيال، والمؤسف في الأمرين تبخر كل أحداثهم من الذاكرة، أفاعيل الفجور ورحلات الخيال كلها تدخل في عداد المنسيات لحظة يتبدد المفعول، إلا أنها تتجدد مع كل حباية، اكتشف سبيل كل تلك الأسرار مع مجريات ذلك اليوم المحوري.
مع فنجان القهوة الملغوم بنصف الحباية العجيبة وحظ الكروت والسيجارة الملغومة التي أعدتها مسبقا بعناية، أصبح كل المتوقع بينهما حادثا، وبعدها بدأت الحكايات، كانت الحكايات بمثابة الفاصل الإعلاني بين كل لقاء، وبالطبع كان الحديث دائما من جانبها، فهو لا يعرف لنفسه حكاية قبل يقظته من الغفوة في العراء.
كان العشيق الزوج في سَفـْــرَةٍ قصيرة لأهله في المنصورة من أجل حضور حفل زفاف، وبالطبع لم يصطحبها، ليست أكثر من عشيقة سرية على كل من يخصوه، لكنها في العمارة وما حولها فقط زوجته، وهي تعيش معه حياة أقل معاناة من حياة عاملات المصانع، وأقل خطورة من حياة احتراف الجسد، تاريخها مع الحياة كان طويلا تلك المرأة، تاريخ مفعم زَخِم، هربت من الاسكندرية بعد أن حاول زوج أمها الاعتداء عليها وكانت حينها لم تتجاوز الـ 15 عاما، لكنها كما تدعي كانت تعاني من مظاهر الأنوثة المبكرة، نعم تعاني، ففي مجتمعات كثيرة تكون الأنوثة الوفيرة في حد ذاتها ذنبا، استقلت ميكروباصا للقاهرة وكانت قد خططت للهروب مسبقا بدقة، فسرقت بعض قطع من ذهب الأم منتخبة أثقلها وزنا وما في حوزتها وحوزة زوجها من مال أثناء نومهما، مما وفر لها فرصة لكنها لم تكن مأمونة.
كانت عيون مدركة لمحدودية السكك المتاحة لها بسبب سنها الصغير، فقررت ألا تضاعف على نفسها المخاطر ولجأت لـ “سمية”، سمية جارةُ عمرٍ من جيل أمها تركت الاسكندرية للقاهرة منذ سنتات تقريبا بسبب نقل وظيفي لزوجها، وهي من أقرب الأرواح لقلب عيون، دبرت لنفسها مبيتا آمنا ثم اتصلت بسمية في الصباح وتواعدتا في لهفة على زيارة فورية في بيتها، ارتابت عيون من فكرة الزوج تحسبا من احتمال وشايته بشأنها لزوج الأم، فطمأنتها سمية بأنه لا يعود من العمل قبل السادسة مساء تحت أي ظرف.
كم هي حميمة حنون هذه الجارة، لم تحاول نصحها بالعودة لذلك البيت تحت أي مبرر أو ضمانات، تحدثت لإحدى صديقاتها وكانت تمتلك وتدير حضانة أطفال وتوسطت لتوظيفها على أن تسكن في مكان العمل، رحبت السيدة وبدأت عيون حياة حقيقية بعد قرار هروبها بأقل من 48 ساعة، مما رسخ في وجدانها يقين صواب هذا الهروب حتى وان بدى من وجهة نظر الكثيرين مشينا واصما.
في كل تلك الحكاية، لم تنتبه ميادة إلا لمشاعر استياء من عيون لم تجد لها مبررا، فهي بالحتم لا تنتمي للغيرة، أي غيرة تكون نحو رجل ظهر في غفلة من المجهول منذ ساعات معدودة، وهو يسير معها الآن على رصيف الكورنيش ولم يتحدث عن أحد منذ بدأ يحكي إلا عن عيون، لكن الأيادي متشابكة منذ بداية النزهة، لم تنفلت مرة ولم يضيقا منها لحظة، وجدت ميادة أنها بالفعل تستلطف قبضة يده الرقيقة على عظام يدها، وبالفعل تكره سماع حكايات عيون، تجاهلت تساؤلات بالها عن سبب هذا الاستلطاف وتلك الكراهية، ولكن على أي حال لن تسمح بهدر يوم كهذا مع حكاوي تلك المرأة.
ـ مش عايز تعرف إيه اللي نزلني من بيتنا فـ حلوان وجابني لحد هنا.. عشان اقعد لوحدي.. واقابلك.. ونبقى بنتمشى مع بعض دلوقتي عشان نروح نتغدى كمان؟
حين سألها في هذا الأمر عند لقائهما على الشاطئ تجاوزته دون إجابة في تجاهل كأنه لم يُطرح، فكانت رسالة صريحة منها بأنها لن تفشِ، وبالتبعية قرر هو ألا يخوض فيه مجددا، أدرك مع الكثير من التجارب والمعاناة في التعامل مع العالم بعد خلقه الجديد في العراء أن للناس دونه تاريخ وأحداث طويلة معقدة، تاريخ غزير يمنحهم رفاهية إخفاء بعض أجزائه دون أن ينقص منه الكثير، وعليه أن يحترم هذا الفارق إذا أراد أن يتواءم مع هذا العالم، لكنه يريد أن يكمل حكاية عيون فعلا، فهو لا يرويها بهذا القدر من الدقة عشقا لها أو استمساكا بتفاصيل زهيدة لتاريخ فقير محدود، بل تمهيدا وافيا لما تركته فيه هذه المرأة من أثر يتمرمغ في نعيمه حتى الآن.
امتد به اليوم مع عيون حتى انتصف الليل، كان متأهبا في أية لحظة لأن تنهي اللقاء وترسله لاستئناف ليلته على مرتبة المنامة المقرفة، لكنها لم تفعل، بل تركته لتحضير أكلة عشاء من سمك الصيادية، كان قد عرف عنها من الحكايات الكثير، زيجات وطلاقات وأسفار وصدمات وانكسارات وتمسك بالحياة أيا ما كلفت من تضحيات، حتى جمعها القدر بلقاء بهذا الكهل الجشِع، ورحبت معه بالحياة عشيقة في ثوب زوجة بينما تحلِب من ثروته خلسة بدهاء فتأمَنُ للحياة بعد أن يملها هذا الرمرام أو يجد لها بديلة، تقضي مع الكهل تلك الشهور حتى تأتيه سفرته المفاجئة فتدعو العشيقة نزيل المنامة المجهول الجذور لقضاء يوم ربما سيمتد بهم إلى التالي، يعود بعده سبيل لمبيته النتن الجاف وتشرُّد المقاصد في كل صباح، لقد شبع من الحكايات، يريد أن يقضي البقية القليلة من مصير هذا اللقاء في عرض مستمر للفحولة، يريد أن يستمتع بنعيم عيون، نعم، هو بالقطع يريد تلك الحباية السحرية التي يبدوا تأثير أفاعيله بفضلها جليا على روح عيون ووجدانها حتى تجلت في عينيه سيدة الأنوثة على هذا الكوكب، ولا بد لسيدة الأنوثة من سيد للذكورة.
نقب خلسة في حقيبة يدها عن شريط الحبوب الذي حفظ لونه، وتناول حباية كاملة، لو كان هذا ما أتت به نصف حباية من الصباح حتى منتصف الليل، فماذا ستأتي به الحباية كاملة، سيكون الفحل الخيالي، سيكون ذكراها التي لن تبرح البال أبدا، لكنه استيقظ في ظهيرة اليوم التالي لا يذكر من الأمس لحظة بعد الدقائق الأولى من ابتلاع الحباية، وكانت عيون في نهاية تلك الدقائق تناديه من الصالة للعشاء، و… فقط.
أما في ظهيرة اليوم التالي، فقد كانت عيون كأنما لا تفقه لنفسها حالا، مبهورة، مذعورة، لا تريد أن تبرح حضنه لأي سبب، لكنها تترقب يقظته كأنما تترقب بشائر حدث مريب.
هذه المرأة قدمت له ما يتمرمغ في نعيمه فعلا حتى الآن، حبوب الخيال السحرية، تبدلت بها كل مفاهيم الحياة، حين يبلعها صباحا، يكون العالم كله متآمرا على إسعاده، تتخابث الظروف وتتبارى في تحقيق كل المبهجات حتى يعود لمأواه ليلا، هو لا يذكر أمرا من مجريات اليوم بعد اليقظة، النوم فاصل كلي يطهّر الذاكرة من كل ما يشغلها ليبدأ مع اليقظة يوما حرا من أي تأثير لذكريات مضت، واليوم بعد أن ابتلعها بمياة النيل، ترك مأواه سابحا، التقى ميادة وَدَعَتْهُ لمشاركة خلوتها وما هو باق من يومها حتى تشاء الرحيل، يتنزهان على الكورنيش متشابكا الأيدي دون تحفظ، وهما في الأساس يقطعان طريقهما للمطعم الذي انتخبته للغداء على كورنيش جاردن سيتي، لا يمكن للأيام أن تكون بكل هذا الجمال دون تلك الحباية.
ـ بس انا حقيقيه مش عفريته فـ خيال حباية عيون يا سبيل..
كانت شديدة الغضب والحسم، فجأة أحس بحرج من فجاجته وارتباك من مغبتها، قد تتركه هنا على الرصيف في منتصف الطريق وتنصرف منتصرة لكبريائها، هي بلا شك بطة حورية تستطيع بإشارة رمش أن تجد لنفسها رفيقا بديلا لن تسمع منه سوى التدليل والغزل، بينما يصر سبيل بكل غباء على استئناف حكايته عن عيون.
ارتبك من صيحة غضبتها للكبرياء، تلفت في الأنحاء خشية أن يكون ما فعلت قد لفت لهم الأنظار، فيسود على حسابه عنفوان المروءة في نفوس زحام العابرين من الرجال ويَلقى على أيديهم ما لا يَحتمل من إهانات وامتهان، لكن الحال كان كما كان، الكل في ملكوته وكأنهما أشباح لا تدركها الأبصار، أما هي، فبدى أنها ارتضت لكبريائها ما طبعته الغضبة من ارتباك في صدره فاستعادت من على الفور ودَّها الرائق.
ـ مش عاوز تعرف إيه اللي جابني من حلوان لحد هنا؟
ـ عاوز..
ـ طب يلا نعدي الشارع.. المطعم اهو.. ناكل ونتكلم.. أنا هموت مـ الجوع..
ثم شبَّكت يدها في يده من جديد عابران نهر الطريق صاعدان درجات السلم الأربعة لباب المطعم داخلان.
على مأدبة غداء فاقت خياله تواجها، بينهما سرافيس المحاشي المشكلة والحمام المحشي والمشاوي والأرز المخلوط بالكبد والأوانص والمكسرات وشفشق لعصير الليمون بالنعناع، وصحن مسطح واسع رصت فيه بأناقة قطع دائرية ملونة مغلفة بطبقة من الأرز وأخرى لأسماك بدت شهية برغم أنها نيئة، يجاورها زوجان من العصي الخشبية الرقيقة، سلطانية صغيرة بها سائل داكن، وقطعة صغيرة من معجون أخضر تُجمِّل جانبا من الصحن، بدى المنظهر شهيا، وتعامل معه سبيل بعفوية ممسكا زوجا من عصي الأكل مسكة خاصة باعتيادية غير منطقية، وأخذ يلتقط من القطع يغمسها في السائل ويضيف لها بعضا قليلا من المعجون ويأكل بسعادة كأنما وجد صنفه المفضل بعد طول اشتياق، لكن الملفت في الأمر كان في عدم اكتراث ميادة بما يفعل بقدر اكتراثها بموقفها الشخصي من الصنف نفسه.
ـ عمري ما حبيت البتاع اللي انت بتاكله ده يا أخي..
ـ بتاع ايه؟
ـ السوشي ده..
اسم هذا الصنف “سوشي”! لم لا! أيا ما كان اسمه فهو لطيف مبهج المنظر مستساغ المذاق، وتلك البطة من الحوريات أمامه أيضا شهية، حتى في طريقة أكلها العفوية المتحمسة من الأطباق التقليدية وقد شرعت تحكي مسترسلة بارتياح من تحكي لنفسها أمام مرآة، فطاولات المطعم خالية لا تدعوا للتشتيت وكل طاقم خدمته مسخر لتلبية ما تأمر به.
تعيش ميادة مع جدتها بعد أن هجرت زوجها لأنه لم يُقـْـدِم عليها يوما وهو في كامل الوعي، سكير محترف، حين يستيقظ صباحا لا يرى من كل كنوزها إلا خادمة تليِّف ظهره في الاستحمام وتـُـفطِره بما يطيب وتكوي ثيابه التي يتخلص منها في ورشته ليرتدي ثياب العمل البالية، يخرج للسعي بكيس تلك الثياب التي دائما ما ينسى تبديلها بالنظيفة بعد نهاية العمل بسبب الشرب، ويأتيها ليلا بغبار خشب الورشة ورائحة زيت التربنتين الخانقة، ينال من لقياها ما يطفئ توهجه في الظلمة تحت الغطاء دون أن تلتقي العيون ولو بلمحة تخبره ما تحمله النظرات ويعتصر به الصدر من أنين الاختناق، بينما لا يكون لها ما تفجر به ألمها المكبوت إلا فضفضة الشكوى للجدة التي دائما ما تجيبها بعبارات الطبطبة البغيضة، كل الرجال يتشابهون، فإن كان مأخذها على الزوج الشرب، فـ له فضيلة أنه لا ينجرف مع السُّكرِ لأخريات، وإن كان لا يرى فيها أو يسمع إلا غريزته المتضخمة بالخمر، فإنجاب طفل سيملأ عالمها بما لن يدع لها مجالا لتعبأ معه بآخر حتى وإن كان زوجا سكيرا بروح جائعة، كذا هي الحياة تسير في كل البيوت، وهكذا تتدبر كل النساء الحكيمات أزماتهن.
كانت آخر لياليها معه منذ 3 ليال، داهمتها في نهار ذلك اليوم الأخير فكرة كابوسية، ماذا لو استبدلت ميادة جسدها بجسد امرأة أخرى عند عودته بغيامة السُّكر، هل سيدرك؟ هل سيشعر؟ هل سيحس فارقا ولو في عبق جسدها المشبعة خلاياه بالعطور الشرقية عن سواها؟ هل يعرفها فعلا؟!
تدمن ميادة كل صنوف العطور الشرقية، تشتري عبواتها الصغيرة المصنعة محليا، تخلط منها على جسدها توليفة حصرية، عود ومسك وعنبر، ربما يظن البعض أن الناتج لن يكون كما ينبغي، لكن هذا الناتج حين يندمج بخلايا ميادة يفوح سحرا، سحر يستوقف كل النفوس ويَلـْـوِح نحوها كل الأعناق حين يغزو بعبقه كل الصدور والقلوب والعقول، لكنه أسفا لا يقوى على هَبوِ التربنتين الخانق والكُحُل الذي يفوح من العشير السكير.
في ظهيرة ذلك اليوم الأخير قبل الهجر، تغلب خيالها الكابوسي على ترددها، كست نفسها بعبايتها السمراء المحبوكة، وانتعلت شبشبا فضيا بكعب متوسط يكشف قدمان انسيابيتان لامعتان من فرط العناية والمخدومة أظافرهم بطلاء وردي، شبشب يؤمن لمشيتها ما يلزم من حضور دون أن يزعجها بألم المسير، استقلت سيارة أجرة استقرت بها أمام برج عملاق من أبراج كورنيش المعادي، صعدت شقة أخبرت حارس أمن العقار أنها لسيدة تدعى “نيفين”، وأمام الشقة، فتحت لها امرأة في وهج منتصف العِقد الثالث ترجمت ملامحها ومفردات حديث ترحابها احترافا أصيلا للغواية، رغم ملابسها المنزلية الأنيقة ونقاء الملامح من مساحيق التجميل وألوانه، استقبلتها نيفين بترحاب احتفالي لصديقة جيرة قديمة، وقضت معها ميادة 3 ساعات استحضرا خلالها أشواق حكايات الطفولة والصبى، ثم حكت لها نيفين حكاية الاسم الحركي الذي لا يعرف محيط علاقاتها وزبائنها غيره، خاصة وأن ميادة لم تكن تناديها إلا باسمها الذي عرفتها وأحبتها به، كان اسمها فيما مضى “درة”، وكانت بحق درة الحارة والحي وحلوان كلها، ثم تنتهي القفشات والذكريات مع فنجان القهوة الثاني بحكاية حسرة ميادة وهاجسها الكابوسي.
فهمت نيفين سبب الزيارة وطبيعة الخدمة التي لجأت لها ميادة من أجلها، ضمت حسرة رفيقة العمر بحضن بث في القلب من جديد دفئ الثقة التي بدت ميادة تفقدها في نفسها.
قبل قدوم الزوج بدقائق، غمرت نيفين جسدها بعطر “غربي” فواح محفز، واتخذت على السرير موقع ميادة بعد أن أعتمت النور، بينما اختبأت الأخرى وراء جانبٍ ساترٍ من الصالة، ويعود الزوج مخمورا ككل الليالي، يندفع نحو السرير وهو يتخلص في تلك المسافة التي يقطعها في الصالة وغرفة النوم مما يستره، يدس نفسه تحت الغطاء فتستقبله ككل ليلة ليفرغ فيها فورانه، ثم يداهمه فتح نور الغرفة الغامر ليكشف نيفين بديلة لميادة، بينما كانت الأخرى تقف بجوار الباب تتطلع لأي لمحة من انتباه أو انفجار غضب أو بشارة ثورة لكبريائه، إلا أنه وبكل عفوية غيبوبة الخمر جذب الغطاء مكفنا به استئناف اللقاء.
من فورها دفعته نيفين مصدومة من فرط القرف ليتدحرج ساقطا أسفل السرير في جهته الداخلية، ارتطم أسفل ظهر رأسه مع السقوط بالحافة البارزة لإطار الكومودينو السفلي، لم يشعر بالألم المفترض لوطأة إنهاك الشرب والمفاجأة، وبين اليقظة والدهشة والغياب تراءت له من أسفل السرير بجوار الباب ساقان واقفتان تأتيهما ساقان أخرتان، ثم سلـَّـم جفنيه لسبات عميق.
لم ير اختلافا في الملامح، لم يتشكك وهلة لاختلاف العطر، ولم يعبأ جسده بفارق القوام بين ميادة وبديلتها، لم يأبه بأمر إلا بشبع الجوع الأعمى.
تركت نيفين الفراش مبهوتة من قسوة القرف، كانت في تلك الخطوات المعدودة التي باعدت بين السرير وميادة عند باب الغرفة قد حسمت قرارا مصيريا لرفيقة طفولتها المسكينة، تعانقتا لتواسي كل منهما وجيعة الأخرى، ثم همست لها نيفين بالقرار.
ـ انتي تلمي هدمتينك وتاخدي بعضك وتنزلي معايا عشان اوديكي عند ستّـك.. وحسك عينك ترجعي لفرشة الخنزير ده تاني حتى لو بتموتي وهو اللي معاه مية المحاياه.. فاهمه يا بت!
بعد 3 ليال من المفاوضات الهاتفية بعد الهجر، أتاها في الأمس مع الظهيرة مسترضيا حتى انتصف بهم الليل، حاول بكل الحيل أن يستعيدها لبيته، أو بتحديد أدق، لسريره ومطبخه.
عاشت ميادة يوما مريرا بكل المعاني في هذا الجدل اليائس، فهو رجل لا يرى من العالم إلا جوعه، جوع لخدمتها وجوع لطبيخها وجوع لمكمنها في ليل سُكْرِه، جوع يعمي كل ما عداه من حواس.
ألح على معرفة سبب استمساكها بهجره وإصرارها على الطلاق بهذا اليقين، وكانت هي لا تجد في القلب شجاعة لتعترف بأن علتها في كبريائها المسحوق، كيانها الذي عاشت مزهوة به وبما يضج من نعم تتحاكى بها الأفواه في حلوان وكل مطرح تطأه أقدامها، تلك العيون التي اعتادت لهفتها حتى ولو بمرورها العابر، وتلك الأمنيات التي ملأت بها أحلام ليالي كل من صادفها من رجال، وسموم الغيرة التي لم يخل مجلس نساء في محيط الحي من بثها في حَرَمِ سيرتها، فتهدأ بعدها نفوسهن دون أن يُحدث الأمر فارقا في واقع هزائمهن البغيضة أمام أول ظهور لميادة ولو بخيال من خلف زجاج غرفة مغلق، لقد هشم السكير كل ذلك التاريخ دون حتى أن يتذكر من فعلته لحظة أو لمحة، عاشت على ذمته تصطبح به وتمسى 7 شهور وهو لا يعرف منها إلا خادمة توفّي له صنوف شهيته وقد دفع أجرتها بالكامل مقدما مع المهر، سيدة مطبخ لا تضاهى نهارا وسيدة فراش للاستخدام ليلا.
غادر السكير منزل الجدة يائسا بعد أن أفرغ جعبة محاولات استردادها من تهديد وثورة وتفخيم لفحولته المرفوضة، ولأول ليلة وجدت ميادة نفسها تسعى للنوم بقلب مطمئن وسكينة كانت قد اشتاقت إليها منذ أن تزوجت، مع الشروق، استيقظت على تلك الرغبة في أن تختفي عن كل ما يذكرها به لتختلي بقلبها مع صفحة النيل في أبعد مكان محتمل عن عيون العارفين والجيرة، فحضّرت للجدة فطورها وقضت بضع ساعات في ترتيب الشقة وإعداد الغداء للسيدة العجوز بمزاج كانت تفتقده، وفي الظهيرة ملأت الثرمس بالشاي وألغمت سيجارتاها واستقلت التاكسي شاردة مع ما تمر به حتى انتبهت من الشرود وكانت أمام مسبيرو فترجلت، كانت حين غادرت قد اتصلت بنيفين لترافقها، لكن الأخرى كانت مشغولة بزبون انتعش لصحبتها فقرر أن يقضي بها اليوم على حوض سباحة في أحد الفنادق الكبرى مقابل مبلغ أتعاب سخي، لذى كانت قد أحضرت معها كوبا وسيجارة إضافيان، ثم رأته على شاطئ النهر، بنيانه المتناسق وشعره الطويل ولحيته الناعمة ونظرته النقية، وجدت فيه ما تطمئن لصحبته والبوح له بغصة في القلب لم تبُح بها إلا لنيفين.
رأت شعره الطويل وسلامة بنيانه ونقاء نظرته، لكنها لم تر بلاء هيأته وبقايا الملابس التي بالكاد تستر الجسد وتفضح بؤس الحال.
كان لحكايتها وقع ثقيل في نفسه، ود حين سمع منها مشهد نيفين في فراشها لو مكنته الأقدار من ذلك الخنزير، فيبرحه ضربا ودهسا وامتهانا حتى يرد لها حصيلة كبريائها المهدر كاملة فتستعيد زهوها المعتاد من جديد، للأسف، لا مجال لفرصة كهذه، ولكن هناك الكثير من البدائل، تزاحمت في باله أفكار بدائل تسُر النفوس المهمومة، وشرع يعرض عليها المقترحات الأنسب في هذا السياق من أجل استئناف مسيرة هذا اليوم المفتوح بعد أن أفرغت أثقال آلامها.
تركا المطعم دون أن يأتيهما النادل بفاتورة الحساب أو يستوقفهما أحد، بل سبقهم صبي للباب يفتحه ليخرجا وهو يودعهما سائلا ميادة أن تكرر الزيارة في أقرب فرصة، وبمجرد وقوفهما على الرصيف توقفت أمامهم سيارة أجرة كان سائقها كهلا بشوش الطلة، ركبا في المقعد الخلفي متجاوران وأخبره سبيل بوجهتهم وكانت للدقي، لم يستغرق المشوار بضع دقائق رغم تأني السائق في القيادة واكتظاظ الشوارع بالسيارات والناس، أما هي فكانت شديدة الحماسة، وبين الحين والآخر، كانت ترفع يده لتطبع عليها قبلة عميقة مشحونة بما لا يجد له “سبيل” تفسيرا، لكنه كان سعيدا… كان في غاية السعادة.
أمام برج ضخم في أول الدقي على شارع التحرير ترجلا، جذبته بثقة نحو باب البرج غير عابئة بدفع الأجرة فارتاب سبيل وهو يلتفت للسائق خلفه وقد تابع الآخر طريقه متبسما راضيا كأنما يبارك مقصدهم.
مدخل فسيح مُهمل الصيانة وسلم طويل في عمق يمينه صعداه لطابق كامل، استقبلهما شاب يقودهما لباب المصعد يفتحه بترحاب ثم سجل زر الطابق الأخير مغلقا الباب، ومع الوصول فـُـتح الباب من الخارج واستقبلهما شاب آخر يرشدهما لباب صالة فسيحة خاوية تفضي لشرفة واسعة وضعت بمحاذات سورها المطل على مشهد ليل المدينة المتلألئ طاولة واحدة يتوسط سطحها شمعدان تتراقص شعلات شموعه مع النسمات دون أن تنطفئ، وكرسيان متجاوران يقابلان مشهد المدينة المفتوح وقد أصبحت ملكهم وكل من عليها خدم للأفكار قبل أن تتحقق.
دون طلب أتاهم الشاب بكوبين فخيمين من كوكتيل الفواكه زاهي الألوان تكلله شرائح طازجة من التفاح والكيوي والبرتقال السكري، كانا متجاوران في اقتراب استدفأت به الأرواح مع تلامس الأكتاف، أما هما فلم يتحدثا مجددا، يستلذان بالعصير والنسمات والمشهد المفتوح في فسحة من السكينة ونغمات موسيقى رائقة تبثها سماعات المكان، مالت ميادة برأسها تتوسد كتفه ومال بوجنته متوسدا رأسها مستنشقا عبق شعرها الكثيف.
آذان بطـَّـن سماء المدينة من مكبرات المآذن المحيطة فتنبها لحالهما مجددا لا يدركان أكان للعشاء أم للفجر، أخبرهما النادل حين سألاه بأنه العشاء فاطمأنت القلوب للوقت، لكن سبيل قرر الرحيل بها إلى وجهة اقتراح جديد لقضاء الليلة.
ـ هتوديني فين تاني؟
ـ خليكي معايا مش هتندمي.. بس متسأليش.. خلي المفاجآت هي اللي تتكلم عن نفسها..
ـ ماشي..
خرجا من بوابة البرج للشارع بينما كانت ميادة تثرثر بما تصف به سرورها ورضاها عن مجريات اليوم، لكنه اصطدم بما أصمه عما تقول، كان الزحام على أشده، ناس وسيارات، يسيران على الرصيف فيرميه المارة من كل صوب بنظرات تفحص أو ريبة أو شفقة، وآخر يمد ساعده خارج شباك سيارته نحو سبيل وهو يضم قبضته على شيء مجهول ويشير بأن يمد له سبيل يده سريعا قبل أن تفتح الإشارة للسير، وحين فعل، حل الرجل قبضته تاركا ما فيها في يده، كانا جنيهان من الفضة، ارتبك سبيل وبدت عليه الخشية من أن يلتفت تجاه مكانها المفترض بجانبه، ثم فاجأه صياح طفل مذعور تسحبه أمه بخطا سريعة لتتجاوز به سبب ذعره فتأكد بأن سبب الذعر كان في هيأته.
توقف سبيل عن السير، تخشب في مكانه يجول ببصره في الأنحاء يقرأ الوجوه والعيون المارة به على اختلاف تعابيرها الكريهة، تسلل للصدر فحيح لهاث ما لبث أن تأكد ثقيلا متلاحقا، وبتردد قرر الالتفات نحوها فلم تكن هناك، تركته ميادة وحيدا غريبا في أرض الحقيقة.
كان يقينه بعدم وجودها في أرض الحقيقة أكيدا فلم ينقب عنها في الأنحاء ولو بلفتة، ثم واصل طريقه قاطعا كوبري قصر النيل حتى شارع رمسيس ثم ميدانه، يستجدي كوب شاي من صاحب نصبة، ويستعطف عابرا من أجل سيجارة، حتى وصل لعمارة منامته القديمة، يرمي بلمحة لباب شرفة شقة عيون المفتوح، ثم ينحني نابشا الحجارة عن مخبئ حصته اليومية التي تعهدت عيون منذ يومهما الأول والأخير معا بتدبيرها له خلسة وإخفائها من أجله على هذا النحو، زجاجة البراندي، علبة سجائر كليوباترا، وورقة ألومينيوم صغيرة تغلف حباية الخيال.
في المستقر أسفل الكوبري، اضجع سبيل على فوتيه الإطارات يجرع من الزجاجة ويدخن وهو يتأمل النيل بأنوار الليل المتراقصة على صفحته، وفي البعد يقبع مسبيرو تجري أسفله السيارات، وبين الحين والآخر يمر به مركب بأضواء ملونة ومرح متنزهين على ضوضاء أغاني المهرجانات المنبعثة من مكبرات الصوت الرديئة.
مع سكينة ساعات اقتراب الفجر، تكون الزجاجة قد فرغت، ويكون سبيل على فرشته متدثرا بغطائه مستسلما للنعاس.
في الأحلام، لا يرى المرء منا نفسه، يشعر بأنها نفسه، يرى بعين نفسه ويسمع بأذنها ويحس بلمسها وجهدها وأنفاسها تتوالى، ولكن دون أن يرى نفسه، وفي حلم الليلة تكون البداية كما اعتاد لا يدرك لها مصدرا ولا يعلم عن شخوصها شيئا، فكل المصادر والشخوص والتاريخ برمته لم يعد حيث كان بعدما أفاق من غفوته في العراء، لكنه رأى فيما رأى أنه يقف في مكان سهر وموسيقى مع رفقة من النساء والرجال حول طاولة عالية، يسكبون في الكؤوس من زجاجات خمور فاخرة يجرعون منها كأنها أكواب ماء، وبين الحين والآخر، يأتي بعُصيِّه من صحن السوشي الواسع بقطعة يتلذذ لطعمها وهو يشاركهم الثرثرة والقهقهة والرقص معانقا الرفيقات غير ممانع من بعض لحظات التجلي فتضج ملابسه على إثر ذلك بروائح عطور السهر النسائية الثقيلة، كان يشم الروائح بوضوح في الحلم.
ثم رآى بيتا، بيت لم يدخل مثله من قبل، لكنه في الحلم بيته، فرش حديث وثير أنيق الألوان، وشرفة تطل على البحر المفتوح لا يستجمع في أي حي أو مدينة، وهو يفتح بابه داخلا مهلهل الثياب بحكم فوضى السهر، مندفعا بسُكره قاطعا الصالة للعمق حيث باب غرفة مفتوح وهو يتخلص من أثقال الثياب والحقيبة يلقيها أينما كان، في تلك الغرفة المظلمة كانت ميادة تنتظره متأهبة تدثر نفسها بغطاء من الحرير إلا عيناها اللتان ترمقانه بفزع رآه جليا رغم العتمة ولم يعبأ، اندس تحت الغطاء بلا مقدمات، وغاص في النيل منها دون تمهيد، ثم أخذت ملامحها تتشكل بملامح امرأة أخرى ثم تعود ميادة للملامح وتختفي لتأتي الأخرى التي كانت بالقطع نيفين، وفي غفلة رأى كأنما أتته رفسات عنيفة منها ألقته من حافة السرير مستشعرا ارتطاما أسفل ظهر رأسه دون أن يستقر بعده على أرض الغرفة، بل واصل سقوطه في هوة سحيقة كأنها لا تنتهي حتى رأى نفسه يُلقى من علٍ على رصيف أسفل سلم كوبري 15 مايو فاقدا الوعي، ثم ما لبث أن أتاه صوت نداء غامض أيقظه، فتح جفونه محلقا بنظرة للسماء فرأى فيما رأى شرائح ستائرها الهفهافة تتدلى من طاقات النور ممتدة حتى كادت تلامس الأرض بعد أن فرشتها المروج الأرجوانية وشقها جدول الماء الرقراق الممتد بطوله نحو الأفق، ومن خلف الستائر ظهر حشد النساء مبهرات الهبات في الحسن، أتينه تتقافزن بخفة الطيور على سطح الجدول حتى انجلت سمات من تقود الحشد وكانت عيون، تجاورها إلى اليسار ميادة، وإلى اليمين كانت نيفين.
مدت له عيون يديها فطاوعها لتصعد به سلم الفيروز إلى عرش الطواويس البيض، ومن عليائه انشرحت روحه لمرحهن في الأنحاء التي تتبدل كأنما تتبدل خلفيات الحياة من أرض لأرض، مطاردات في غابة الزهور ورقص في واحة النخيل إلى بناء بيت الشعاب والأصداف على شاطئ إحدى جزر الكاريبي، ثم تقفزن من مصب شلال أعلى جبل الجليد وتغطسن في نهر تحفّه قصور من كل العصور سابحات خارجات منه جريا كقطيع الغزلان نحو باب القصر المهيب، وهناك، يشاهد مع الرواد من علياء عرشه الذي انخفضت درجاته إلى ثلاثة عرض الغواية حتى تأتيه نفس النهاية، يتصاعد الصياح والتصفيق حتى يتفاقم فاقدا مرحه نافخا في الأذن طنينا مدويا شديد الإيلام، وتترك النساء المسرح إليه تـُـحطنه في نصف دائرة، ثم تأمر عيون فتتقدمن وقد أتت بميادة ونيفين في الصدارة من أجل ذلك الاحتضان الجماعي الشبق المعبق بخليط عطور الشرق والغرب الخانقة تثقل الأنفاس حتى تنقطع.
نهاية
نرشح لك: لنتحدث عن الحياة قليلا.. قصة قصيرة لـ حازم متولي
شاهد: هبة الأباصيري في حلقة جديدة من برنامج “مش عادي”: “لا يمكن أن أرتبط بهذا الرجل”